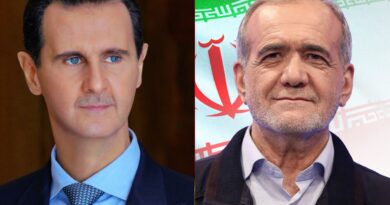الخمسين الأولى شمس وسفينة
غالية خوجة
اعتدتُ أن أعتبر الخمسين الأولى من عمري تجريبية، وأشعل لها شمعة واحدة، لأنني أرى أن كلّ خمسين سنة من أعمارنا تعادل سنة واحدة من عمر الإنسان، لماذا؟ لأن العمر الحقيقي هو ما ننجزه من أثر يدوم، وحكمة تُصان وتصون، وخير نفعله، وأهداف بيضاء نحققها، وما الأعمار إلاّ كينونة الضرورة المكتوبة على الإنسان والجماد والحيوان.
ولهذا، وزّع علم النفس الحديث الأعمار إلى فئات، منها العمر الجسمي ككتلة حيّة فيزيائية، والعمر العقلي المرتبط بنضوج الوعي والإدراك والفاعلية الذهنية والمخيلتية والإبداعية، والعمر النفسي المرتبط بالحيوية الداخلية وإحساسها بذاتها والعالم، لذلك، يُقال: هذه ذات شخصية طفولية، وذاك بشخصية عجوز، وتلك بشخصية أمّ، وذاك بشخصية فيلسوف.
ولا ينفصل العمر القلبي عن هذه الأعمار، وهو عمر معنوي مرتبط بشفافية القلب كرمز وضمير ومحبة ورحمة وتفاؤل وبصيرة كاشفة، فكلما شفّ القلب تراءى، وكلما أصابته القتامة رمتْه بالعوالم المادية على حساب العوامل الحياتية المتناغمة معاً.
وتتكلّل هذه الأعمار المختلفة للإنسان بالعمر الروحي المتّسع ليشمل استبصار الكينونة ويدور في الفضاء حلزونياً، ليؤدي حالته المولوية الخاصة به، متنقلاً بين ذاته والعطاء والعالم والمجرات والكون، وهذا ما توافد عليه الكثير من المتصوفة والشعراء والعلماء وأهل المعرفة.
وتتكامل هذه الفئات العمرية مع عمر الجسد المتشكّل من الجسم والروح والنفس، وتمنحنا خياراتنا في هذه الحياة التي تأخذنا من موجة إلى عمق إلى شاطئ، ولربما هذا ما شعر به آرثر رامبو حين كتب قصيدته “المركب النشوان” ليخبرنا عن نفسه التي كانت ذاك المركب في مياه الوجود، ولربما هي ذاتها التي تراءاها سان جون بيرس في مجموعته “المراكب”.
ترى، هل لسفينة نوح عليه السلام علاقة بهذه الرمزية؟..
ربما، فيما لو حمّلنا دلالاتها هذه الإشارية، وجعلناها إحدى احتمالات الذات كسفينة لننجو بها ومعها من عواصف الشر التي بداخلنا أولاً، ثم التي بدواخل غيرنا، وكذا ننجو بها ومعها من زلازل حقد الذات والآخر، وبراكين الانتقام المختلفة، منادين في أعماقنا: “بسم الله مجراها ومرساها”.
ستسمع نداءنا الفصول، والقلوب، والورود، والغيوم، والألوان، والغابات، والأناشيد، والأساطير، والخرافات، وسترفرف حولنا الطيور والنوارس والعصافير والفراشات لتشاركنا في شعلة الخمسين الأولى وهي تبتعد مثل طفل يحبو على الموسيقا لمرته الأولى.
سيحدث أن يصادف الطفل الرمال والصخور والأودية والعقارب والأفاعي، ويمرّ دون اكتراث إلى الشاطئ، منتظراً سفينته التي صنعها خلال الفترة الماضية، وما إن يراها، يقترب أكثر، وهي تقترب أكثر، ليجدها مثقوبة، أو متكسرة، أو باذخة، فإمّا أنه سيسبح، أو يغوص، أو يحلق، وإمّا سيغرق، ويتحوّل إلى شخصية “الغريق” في قصة غابرييل غارسيا ماركيز، أو يتحول إلى أغنية في البراري، تحفظها البلابل وتردّد صداها الجبال، أو يصير بحراً يموج في الفضاء، فيقابل مراكبَ الآخرين، وسفنَ المائجين، ويلتحق بركْب الهائمين بين البرزخ والوصول.
وبين شمس وأخرى، وموجة وأخرى، وفكرة وأخرى، تجذبنا الإضاءة العميقة، ونظل مجدّفين على أمل أن ننجز رسالتنا، ثم نضعها في قارورة زجاجية، ونلقيها في بحر الأزمنة، ليجدها صقر، أو نسر، مركب، أو سفينة، شمس، أو قمر، موجة، أو شاطئ، طفل، أو طفلة تفرح بها كهدية أرسلها القدر لتكون بين يديها، أو يجدها قارئ متأمّل في ذاته وتحولاتها، فيرفع أشرعة سفينته ويبحر مع هذه الكلمات إلى لغاتٍ تحيا بلا أزمنة، تبحر في الأزمنة، وتصير المراكبَ والمياه والحياة والأمكنة والأزمنة.
ميلاد سعيد لكل قارئ وقارئة، وإشعال لشمس جديدة تتحوّل إلى مراكبَ عارفة.