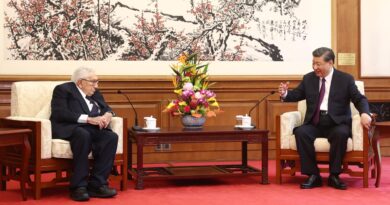الدول العربية ترسم طريقاً لمستقبل جديد قمة جدة.. مرحلة جديدة في الانفتاح العربي تنتظر الترجمة على أرض الواقع
البعث الأسبوعية – علي اليوسف
يمكن القول أن “قمة جدة” كانت إعلاناً صريحاً ببداية حقبة عربية مختلفة، يخط فيها العرب مساراً جديداً، وانطلاق مرحلة جديدة من العمل الذي يستند إلى التضامن، ولم الشمل، وتصفير المشاكل العربية، وعودة التضامن بكافة أشكاله. كما يمكن أن يطلق على القمة “قمة لم الشمل والتضامن والمستقبل العربي”، لأنها ستكون نقطة انطلاق لعمل عربي مشترك يواجه التحديات العربية والإقليمية والدولية، ويرسم طريقاً لمستقبل عربي جديد.
وتأتي أهمية القمة بأنها عقدت بعد جهود عربية خالصة من أجل لم الشمل العربي من العراق إلى سورية إلى اليمن وليبيا ولبنان، وجميع الملفات الساخنة، حيث كانت الكلمات التي ألقاها قادة الدول العربية وممثلوها خير دليل على وجود قواسم مشتركة للتعاطي مع مشكلات المنطقة، ومع التحديات التي تواجهها وسط عواصف يشهدها العالم.
لقد انتهت أعمال القمة، لكن نهاية أعمالها من المفترض أن تكون بداية العمل الجاد لتنفيذ ما جاء في البيان الختامي وترجمته على أرض الواقع، خاصةً أنها تحمل الكثير من القرارات ومشاريع التعاون العربي المشترك. ولأنها بالدرجة الأولى “قمة المصالحة ولم الشمل”، فإن ذلك يتطلب الترجمة بإستراتيجية عمل جديدة على مستوى الدول العربية ودول الإقليم أيضاً.
هذه الاستراتيجية الجديدة، من الطبيعي، أن تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية وثقافية وتنموية واجتماعية وغيرها، وهي تتطلب وضع آليات جديدة تختلف عن الأدوات السابقة، لأن المرحلة الحالية والظروف التي تحيط بالمنطقة العربية، وخاصة الاتجاه نحو عالم متعدد الأقطاب، لا تحتمل أي تأخير إذا ما أراد العرب بناء قوة اقتصادية وسياسية عربية يستطيعون من خلالها تحديد مكانة العرب الطبيعية ضمن التكتلات الجديدة، وخاصة أن الظروف مهيأة، والأرضية موجودة، والإمكانات متوافرة، وإن تحقيق ذلك ليس بالأمر الصعب، خاصة أن قرارات قمة جدة أكدت ذلك، وترتقي إلى مستوى التحديات الجديدة، ليس على مستوى السياسة فحسب، بل على مستوى الاقتصاد.
الخطوة الأولى برفع العقوبات
ومن الضروري أن يترجم قرار وزراء الخارجية العرب رقم 8914 الذي ينص على استئناف مشاركة وفود سورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية ابتداء من 7 /5 /2023، برفع العقوبات الاقتصادية العربية عن سورية من جهة، ومطالبة الإدارة الأمريكية بإلغاء أو تجميد عقوباتها الأحادية على سورية، من جهة أخرى.
صحيح أن تأكيد الحكومات العربية الالتزام بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها، وأهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية لمساعدة سورية في الخروج من أزمتها له أهمية خاصة، ولكن الأكثر أهمية هو رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عنها، لأن سورية لم تطالب بالاعتراف بما تسبب به ما يسمى “الربيع العربي” من خراب سياسي وحروب واضطرابات، وإنما البدء بمرحلة جديدة من التعاون الفعال بين دول المنطقة يحقق لها الأمن والاستقرار والنمو، وعليه فإن البداية يجب أن تكون بمساعدة سورية فعلياً بما تمتلك الحكومات العربية من طاقات وإمكانات لإنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة على مدار السنوات الماضية، وترجمة البيانات الورقية إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، لأن المشاركة الجدية والواسعة بإعادة الإعمار هي الكفيلة وحدها بحل مشكلة عودة اللاجئين إلى مناطقهم المدمرة، وبالتالي فإن العقوبات الأمريكية تصبح لاغية بحكم الأمر الواقع، وسيضطر الغرب إلى مراجعة حساباته ورهاناته.
العقوبات الأمريكية
لم تتوقف أمريكا عن ممارسة الضغوط على الحكومات العربية للجم اندفاعها باتجاه إعادة علاقاتها الطبيعية مع سورية، حيث تنوعت هذه الضغوط مابين النصائح الدبلوماسية العلنية، والتهديد بتطبيق ما يسمى “قانون قيصر” على كل دولة تقيم علاقات سياسية واقتصادية مع الحكومة السورية، وكان آخرها ما صدر عن اجتماع قمة مجموعة السبع الكبار قبل أيام في طوكيو.
إن ما جرى قبل انعقاد القمة العربية في جدة لم يكن مفاجئاً، فالإدارة الأمريكية لم تتوقف عن توجيه التحذيرات والتهديدات من حضور سورية للقمة، لكن لم يتوقع الكثيرون، بل غالباً فوجئوا بأن يتحول الكونغرس الأمريكي إلى خلية نحل شغلها الشاغل حرق المراحل القانونية لإقرار قانون يمنع الإدارة الأمريكية من إقامة أي اتصال مع الحكومة السورية، وبتوسيع قانون “قيصر” لناحية تشديد العقوبات لمنع أي حكومة عربية من مساعدة سورية في إعادة الإعمار.
ولقد كانت هناك إشارات استفهام كثيرة يثيرها الأمريكي من عودة سورية إلى مقعدها في الجامعة العربية، إذ ما معنى أن يؤكد البيت الأبيض أنه متمسّك بموقفه بعدم التطبيع مع سورية، وعدم رفع العقوبات ضدها، أو المشاركة في إعادة إعمارها.
المعنى الحقيقي للتصريحات الأمريكية هو الاصرار على الإمعان في مأساة الشعب السوري، ولعلّ الدليل الذي لا يدع مجالاً للشك في المواقف العدائية ضد الشعب السوري، هو قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي مدّد فيه العقوبات المفروضة على سورية عاماً آخر، وبالتالي الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان في سورية، وسرقة نفطها وقمحها.
لم يدرك بايدن ودولته العميقة أن القصة انتهت اليوم، وفشلت الأدوات، وبقيت سورية في مكانها بوزنها ودورها العربي والإقليمي، وأن سورية لا تخضع لشروط أحد، فيدها ممدودة للتعاون مع محيطها العربي والإقليمي، ومنفتحة على جميع الجهود لحل الأزمة في سورية، طالما كانت تلك الجهود والمبادرات تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على السيادة والاستقلال، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، وأن سورية لا تساوم أبداً في حتمية إنهاء التواجد العسكري غير الشرعي فوق أراضيها وتحقيق وحدة أراضيها.
لقد باتت الأجواء الإيجابية تسري في المنطقة، ونسائم الانفراج تسود المشهد العربي والإقليمي، والأمر الملفت هو تحقيق نوع من الانفتاح، أو إعادة الثقة والاعتبار الى الدبلوماسية العربية في مواجهة التدخلات والمشاريع، وأجندات الدول الاستعمارية والإقليمية التي تتحكم وتصادر القرار السيادي للكثير من تلك الدول. من هنا إن جوهر ما تم طرحه هو تحقيق الكثير من الأهداف، ومن أهمها تخفيف أثار وارتدادات الأزمة السورية على الكثير من الدول العربية المجاورة لسورية، ولاسيما قضية اللاجئين، وتبعات هذا الموضوع فيما يخص المسائل الاقتصادية، وأعبائها المالية على استقرار تلك الدول، بالإضافة إلى تحقيق نوع من التفاهمات الأمنية المشتركة.
معطيات إقليمية ودولية
بلغة السياسة، لو كان العرب يداً واحدة لما هب “الربيع العربي” على المنطقة، ولما تمادى الكيان الإسرائيلي في إجرامه وصهيونيته تجاه الشعب الفلسطيني. وفي حين أن عودة سورية كانت حديث وسائل الإعلام العربية والإقليمية، مرحبة ومهللة بهذه العودة الحميدة، لم تستطع بعض الحكومات الغربية ووسائل إعلامها، وعلى رأسها الولايات المتحدة من لجم غيظها وكيدها، ولكن كل هذا لا يهم طالما أن قطار السلام في المنطقة العربية انطلق، حيث تشير كل المعطيات على الأرض أن ثمة “تسونامي الدبلوماسية” تجري الآن في الشرق الأوسط، وهو ما سيحرم الولايات المتحدة من إمكانية الاستمرار في سياسة النهب والترويع.
من الواضح أن الأساس في كل هذا “الانقلاب” هو السعودية، التي بدأت بالتحول في الولاء على الأقل منذ ارتباط روسيا بمنظمة “أوبك +”، حين اتفقت روسيا والسعودية على مواجهة إنتاج الغاز الصخري الأمريكي. كما أن صعود الصين يبقى العامل الرئيسي هنا أيضاً، خاصةً في أعقاب الاتفاق الذي توسطت فيه الصين بين السعودية وإيران.
وهنا من المهم فهم الموقف الدبلوماسي السعودي في سياق تعريف جديد لسياستها الخارجية، وهو ما ينعكس في الاتفاقية التاريخية الموقعة مع إيران، اذ يسعى هذا النهج الجديد إلى الاستقرار الإقليمي من خلال حل النزاعات، وتصفير المشاكل، بدلاً من استراتيجيات الاحتواء العسكرية، وهذا ما دعا إليه وزير الخارجية السعودي في دمشق بالقول “إن هدف السعوديين هو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية لوضع حد لردود الفعل العكسية في المنطقة من خلال الحفاظ على الوحدة والاستقرار والهوية العربية لسورية، والسماح لها بالاندماج في بيئتها العربية”.
هذا التقدم الدبلوماسي الكبير بين الرياض ودمشق يشكل أحدث المؤشرات الواضحة لفقدان هيمنة الولايات المتحدة في المنطقة، حيث تراجعت بصمتها العسكرية والدبلوماسية بشكل مطرد في غضون السنوات الأخيرة. فخلال العام الماضي، وجدت الولايات المتحدة نفسها مهمشة بشكل متزايد في غرب آسيا، بسبب عقود من التدخل العسكري والإكراه الاقتصادي، فيما قاد الحلفاء السابقون مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المبادرة، وأقاموا علاقات تجارية وأمنية وثيقة مع روسيا والصين وإيران. بينما ملأت الصين الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة من خلال التوسط في انفراج تاريخي بين طهران والرياض، وهو الذي مهد الطريق لمحادثات السلام الجارية في اليمن، كما استعرضت روسيا قوتها الدبلوماسية لحل الأزمة السورية من خلال استضافة عدة اجتماعات رفيعة المستوى شارك فيها مسؤولون سوريون وأتراك وإيرانيون لإنهاء احتلال أنقرة لشمال سورية.
ما من شك في أن هناك مؤشرات إيجابية ترافقت مع عودة سورية إلى مكانها في الجامعة، ومن هذه المؤشرات عدم الإصغاء للصوت الأمريكي باستمرار الدول العربية بمقاطعة سورية، والتقارب السعودي- الإيراني بوساطة صينية، وزيادة عدد الدول التي تنوي التوجه شرقاً، وتراجع التأثير الأمريكي في منع دول المنطقة من إقامة علاقات مع الصين وروسيا ودول العالم الأخرى من دون قيود، وهذه صحوة جديدة على حساب التحكم الأمريكي في سياسات المنطقة وبداية للتحرر والانعتاق من القبضة الأمريكية التي سيطرت عقوداً طويلة على مقدرات دول المنطقة ولاسيما الدول العربية.
تحول استراتيجي
كل المؤشرات والمعطيات تدل على أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الانفتاح العربي مع سورية، وهي بالطبع حركة لاحقة للتضامن العربي منذ الزلزال، لجهة تقديم المساعدات العينية والمادية التي تحتاجها سورية بعد الحرب الإرهابية التي فرضت عليها، وبعد سلسلة الحصارات والعقوبات التي أنهكت الشعب السوري، ليتوج مؤخراً باستعادة سورية لمقعدها في الجامعة العربية بعد حركة دبلوماسية نشطة بين دمشق والعواصم العربية الأخرى، وحضورها القمة العربية في 19 أيار الجاري في جدة بالمملكة العربية السعودية.
هذه المؤشرات هي الحلقة الأولى في كسر القيود الاقتصادية والمالية الناجمة عن العقوبات الأحادية المفروضة على سورية. صحيح أن الانفتاح العربي لن يسير بالسرعة المطلوبة، بسبب القيود الأمريكية والأوروبية، لكن من المؤكد أنه سيتقدّم، لأن أحداث التاريخ المعاصر أثبتت أن سورية مفتاح الشرق العربي، ولهذا كان التآمر عليها، وهي اليوم تواجه الكثير الكثير من التحديات مثل الاحتلال الأمريكي في الشمال الشرقي، والتركي في الشمال الغربي، والإسرائيلي في الجنوب، بالإضافة إلى الإرهاب التكفيري وما نجم عنه من نزوح داخلي وخارجي، وتدمير للبنية الاجتماعية والاقتصادية السورية، ناهيك عن الحصار الغربي الذي يتحرّك بوحي من الحركة الصهيونية.
إن مخرجات القمة العربية ستكون فرصة كبيرة لمحاولة تحويل المأساة التي عاشتها سورية والشعب السوري إلى قناة واضحة ومفتوحة أمام مشاركة دبلوماسية مستدامة. وما دام هناك واقع جديد ومقررات تاريخية لها أبعاد مشتركة مع الدول العربية، فإن عودة سورية لموقعها العربي ستنعكس أيضاً على صعيد العلاقات الدولية، حيث إن سورية تبقى مركزاً مهماً بالنسبة للقرار العربي وتوجيه السياسيات العربية تجاه الأصدقاء. لذلك إن عودة سورية تمثل تحولاً استراتيجياً كبيراً يرتبط بأمن واستقرار المنطقة، حيث ستبدأ المسائل المتعلقة بالتضامن العربي- العربي بالانتقال لمرحلة الترجمة الفعلية ما بعد قمة الرياض، حيث يؤمل أن يساهم الأشقاء العرب برفد سورية بما تحتاجه من إمكانيات لإعادة الإعمار و الاستقرار.
رغم العوامل الإيجابية التي تهيئ الأجواء لمخرجات القمة، يظل الجانب الاقتصادي في مقدمة الملفات التي باتت تحتاج لمعالجة خاصة في ظل تداعيات الأزمة العالمية، والأزمة الأوكرانية التي خلقت بعض الفتور مع واشنطن ودول الغرب. وثمة جوانب إيجابية أخرى تتمثل في الرغبة الجادة هذه المرة، نحو لم الشمل العربي، والعمل على تصفير الأزمات، وصياغة رؤية جماعية تستفيد من أخطاء السنوات الماضية، وتعيد بلورة آليات العمل العربي المشترك في ظل تحديات إقليمية وعالمية.