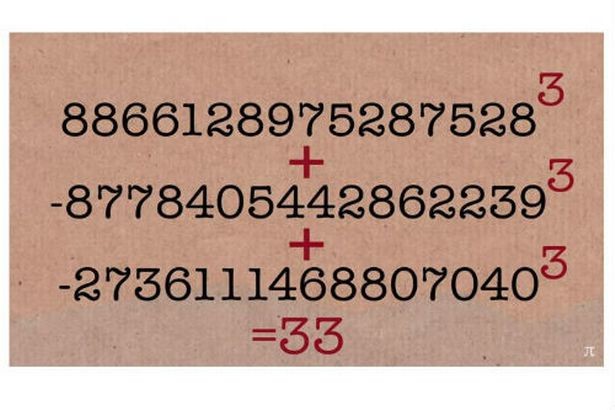رباب أحمد: نفتقر إلى التّجمّعات الثّقافية وإرث والدي أمانة
نجوى صليبه
يمتنع بعض المثقفين – أو يعتذر – عن قبول التّكليف بمناصب إدارية لأسباب خاصّة وأخرى عامّة، لكن الأمر مع الفنّانة التّشكيلية رباب أحمد مختلف كثيراً، تقول: عندما كُلّفت بإدارة المركز الثّقافي في أبو رمانة، كانت الظّروف صعبة جداً، وعددت الاعتذار أمراً غير وطنيّ، وكان العمل يأخذ مني وقتاً طويلاً، حتّى يوم السّبت الذي هو عطلة رسميّة كنّا نعمل فيه، وكنت أحضر معظم الفعاليات إن لم يكن جميعها، ولاسيّما أنّنا انطلقنا بثوابت تشمل الطّيف الثّقافي كلّه، وشرائح المجتمع جميعها، وهذا ما جعلني مقصّرة بحقّ الفنّ التشكيلي كوجود، لكن كدعم لم أقصّر، فقد حرصت على أن يكون المركز رائداً في استقطاب الفنّانين الشّباب والمخضرمين والهواة، تالياً كان المركز منارةً تشكيليةً في غياب صالات العرض الخاصّة التي توقّفت خلال فترة الحرب لأسباب عدّة، هذا بالإضافة إلى تكريم فنّانين تشكيليين وهم على قيد الحياة، كتكريم الرّاحل ممتاز البحرة وإخراجه من اعتكافه الطّويل، أمّا بالنّسبة إليّ فكان لقاؤه أمنية وتحققت، وبذلك تحوّل المركز إلى تظاهرةٍ فنيةٍ تشكيليةٍ ترفع سوية الرّؤية البصرية، ولم يعد الفنّ التّشكيلي مظلوماً كما في السّابق.
وبالسّؤال عمّا إذا ساهمت هذه المعارض في ردم الهوّة بين الجمهور والفنّ التّشكيلي؟ تجيب أحمد: قبل الحرب، كان الفنّان التّشكيلي السّوري رائداً على مستوى الوطن العربي، وكان هناك أسماء عالمية نفتخر فيها، ولدينا اليوم مواهب شابّة بحاجة إلى الاهتمام وإلى أماكن تدعمهم، لكن الضّائقة الاقتصادية أصابتهم كما أصابتنا جميعاً، وأستطيع الحديث عن هذه الهوّة من خلال المعارض التي كان نقيمها ونتبعها بنشاط أدبي مثلاً، وتالياً نفسح المجال أمام جمهوري الفنّ والأدب للتّلاقي والتّعارف والنّقاش، وبذلك أصبح المكان ملوّناً ومنتعشاً تشكيلياً، كما عملنا على الرّؤية البصرية من خلال تزيين قاعة المحاضرات بلوحات وأعمال أهداها فنّانون إلى المركز.
وتعرّج أحمد على مشكلة كبيرة عانيناها ونعانيها وهي قلة الاهتمام بحصة الرّسم والفنون في المدارس، تقول: الفنّ التّشكيلي كان نائياً بنفسه لأنّه كان حكراً على الصّالات الخاصّة، ولم يكن هناك تواصل مع المجتمع بشكلٍ كاملٍ بسبب عدم الاهتمام بحصّة الرّسم، وأنا أؤكّد دائماً أنّ الفنّ أداة قوية في وجه العنف، ويجب تفعيلها في كلّ حيّ.
مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق مدير المركز الثّقافي، لذا يجب أن يكون أهلاً لها، تبيّن أحمد: من المهمّ جدّاً أن يكون مدير المركز على قدر من الثّقافة، إن لم يكن في الأصل أديباً، سواء أكان روائياً أم شاعراً أم موسيقياً.. إلخ. أي يجب أن يعي أهميّة الثّقافة وأن يكون له مشروعه الثّقافي ويبني منهجاً لاستقطاب المثقفين الآخرين، أمّا بالنّسبة إليّ فكان الأمر صموداً ثقافيّاً من حفلات توقيع الكتب والعروض السّينمائية والحفلات الموسيقية إلى النّدوات السّياسية التي شارك فيها شخصيات وطنية من مختلف المشارب الحزبية العريقة والمرخّصة والمستقلة، طبعاً حرصنا حينها على الإعلان عن هذه النّدوات واللقاءات عبر كلّ السّبل المتاحة، ولم يقصّر الإعلام في تلك الفترة أبداً.
كلام يدفعنا إلى السّؤال عمّا إذا كان المثقّف السّوري يتمتّع بالوعي السّياسي أم لا، توضّح أحمد: عندما يرى المثقّف كلّ ما يجري في المجتمع يصبح حكيماً في إيصال المعلومة والخبر إلى المتلقي، فلا يبيع وهماً ولا يثبط عزيمةً.. نعم هناك مثقّفون نأوا بأنفسهم، وهذا شأن خاصّ ولكلّ أسبابه، وهناك مثقّفون لم يعلنوا عن مواقفهم، وهناك جزء كبير كان سلبياً لكنّه غيّر رأيه ورفع صوته بقوّة ودافع عن البلد عندما اتّضحت الحقائق وأصبح على علم بالمؤامرات التي حيكت وتحاك ضد البلد، لكن يبقى هناك خلاف حقيقي مع من كان لديه مشروعه ضدّ سورية، مضيفةً: في بداية الأحداث كان هناك ارتباك كبير وصدمة كبيرة، والعدوّ خبيث حاربنا بالصّدمات المتتابعة، وهاجمنا إعلاميّاً بالتّوازي مع الهجوم العسكري، وأمام هكذا مخطط كانت أيّ دولة في العالم سترتبك، فما بالنا بالمثقّف؟ ولاسيّما أنّ العدو وأدواته استخدموا مصطلحات ثقافية نبيلة لتحقيق أهداف غير نبيلة، ما تسبّب بفوضى ذهنية، لكن من امتلك ثقافة سياسية حينها كان محصّناً.
دور جديد وملحّ على المثقّف، اليوم، أن يؤدّيه على أتمّ وجه وهو الدّور الاجتماعي، لكن ما مستوى جهوزيته؟ توضّح أحمد: لا يوجد حاضنة جامعة للمثقّفين بشكلٍ عامّ، وعندما يغرّد قلم المثقّف وحيداً يكون هناك خلل ما أو تقصير في المعلومات أو الرّؤية التّشاركية معدومة، مضيفةً: المثقّفون الذين يمتلكون ناصية الوعي يستطيعون بتعاضدهم مع مثقّفين آخرين إنشاء مشروع ثقافي مجتمعي، لكن للأسف نتيجة الالتباس الحاصل في بداية الأزمة كان المثقّف يشعر بالوحدة في أيّ اتّجاه كان، لأنّنا نفتقر إلى التّجمّعات الثّقافية، وهنا لابدّ من التّنويه بأنّ المركز الثّقافي في “أبو رمانة” لم يكن لينجح لولا تعاون المؤسسات الحكومية مع المجتمع المدني الذي شارك ببطولة بنشاطات وفعاليات ومبادرات متنوّعة.
التّعاون والتّعاضد والتّشارك مصطلحات أهملها البعض وربّما ألغاها بقصد أو من دونه، ويقودنا الحديث عنها إلى ما سمعناه ونسمعه عن محاربة المثّقف النّاجح سواء أكان في منصب إدراي أم لا؟ فهل الأمر كذلك بالنّسبة لرباب أحمد؟ تبيّن: يسوق الحديث عن سلبيات المنصب الإداري إلى دعوة كلّ المثقّفين إلى نشر ثقافة النّجاح المشترك والفرح المشترك والكورال المشترك، هذه الثّقافة المجتمعة تنقذ مجتمعاً بكامله، فالثّقافة سلوك، وهذا ما نتلمّسه عند الأمم النّاجحة والعظيمة التي يتشارك أهلها في دعم النّاجح والفرح لفرحه، وفي تنظيف الحديقة والشّارع والمدرسة.
بعد ثماني سنوات من العمل الإداري، تتفرّغ رباب أحمد لألوانها ومرسمها وفنّها، تقول: خلال تلك السّنوات لم أشتغل سوى عملين، وبعض الاسكتشات التي أنجزتها خلال فترة الحظر التي فرضها فيروس “كورونا”، وفي المستقبل القريب قد أقيم معرضاً فردياً أو جماعياً حسب الظّروف.
الحوار مع الفنّانة التّشكيلية رباب أحمد لا يمكن أن ينتهي من دون السّؤال عن إرث والدها، أحمد إسكندر أحمد، الذي شغل منصب وزير الإعلام منذ عام 1974 وحتّى وفاته في عام 1983، تقول: زادي في الأدب واهتمامي بالسّياسة كانا بفضل المكتبة الكبيرة التي تركها والدي، وسخّرت هذه المعرفة في عملي كمديرة للمركز الثّقافي في أبو رمانة.. إرث الوالد أمانة أكثر منه مسؤولية، وأنا معجبة به ليس كوالد فقط، بل كرجلٍ وطنيّ وسياسيّ وإعلامي بامتياز، وخلال السنوات الثماني لاستلامي المركز زارني عدد كبير ممن عاصر والدي ليتعرفوا على ابنته وليحدثوني عن مآثره معهم على الصعيد الإنساني والإعلامي.