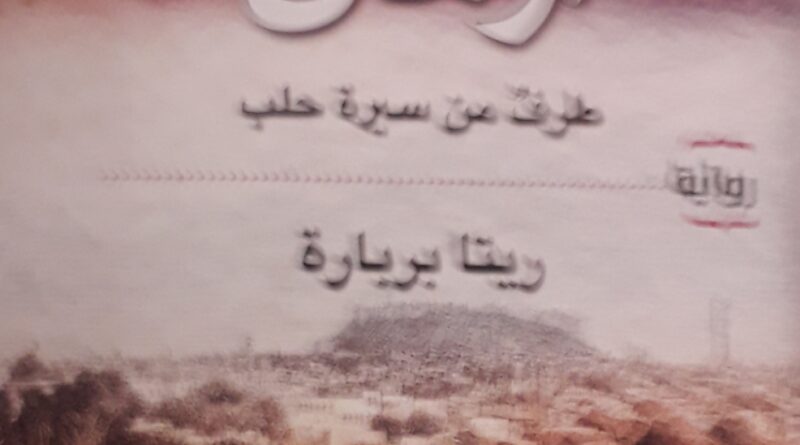في روايتها “أرمان” ريتا بربارة تحكي شيئاَ عن مآسي حلب
فيصل خرتش
تبدأ الرواية برنين الهاتف المحمول، فالمتصل هو “كريكور” الذي يخدم بالقرب من دمشق، والذي يجيبه على الهاتف هي أمه، إنه يسأل عنهم وعن الأقرباء، ترتعش الأم، كيف يمكن أن تخبره، وهي تعلم أنه يحبَ عمَه كثيراَ، وحين يلح بالسؤال، تخبره أنَ عمَه أصيب بشظايا قذيفة هاون وأنه استشهد، يغيب الصوت، ربما غاب عن الوعي، وأمه تردَ عليه بالصراخ لعله يردَ عليها، ولكن يأتيها صوت غريب، فتطلب الأمَ منه ومن أصدقائه أن يكونوا إلى جانب ولدها، ويجيب الصوت، بأنهم معه، فعليها ألا تخاف، وعندها يغلق الهاتف.
الرواية تحكي قصصاً عن الشهداء، ولكن قبل ذلك لابد أن نتحدَث عن المآسي التي ترافقت معهم، فالأم تذهب إلى منزل العائلة لتكون بجانب زوجته وأولاده، إنَ زوجها ذهب إلى المستشفى لاستلام جثمان أخيه، وهي تطلَ من شرفة المنزل فترى زوج جارتها فتطلب منه أن يذهب معها إليهم، يلبي سريعاً، وبخطوات سريعة سارا، ولكن فجأة يمسك بيدها وينبطحان أرضاً كي لا يخترق الرصاص العابث جسديهما، لقد انهمر الرصاص عليهما، ثمَ نهضا وبشكل حلزوني، لتسقط أمامهما قذيفة هاون، يجلسان خلف سيارة ليحميا نفسيهما من الشظايا، تابعا الجري، ليتفاجأا بكم كبير من الرصاص المتساقط، فتشده إلى مدخل بناية، وحينذاك تقول: أشعر بألم شديد لما آل إليه حال حلب، هذه المدينة التي كانت عروساً تتباهى بعراقة تاريخها وآثارها من أبواب وأسواق وحمامات، مؤلم هذا الخراب والدمار في هذه المدينة، وكأنَ الغلَ والحقد يملآن قلوبهم لدرجة أنهم يعملون على مسح معالم مدينة حلب.
وتصف جنازة كريكور وكيف انزلوا الشهيد وصلوا على جثمانه، وحمله رفاقه على أكتافهم يدورون بجثمانه مهللين لشهادته، ومن ثمَ إلى مثواه الأخير.
أخذت تردد جملته التي حفظها كلُ من كان يعرفه: ” شهيد ورا شهيد .. وغير الوطن ما بنريد”، وظلَت “أمل” تذهب كل يوم اثنين تزور قبر الشهيد، تصل القبر، بعد أن تلقي التحية على الشهداء، ففي ذاك القبر قطعة من قلبها.
كانت أمل متوسطة الطول ذات بشرة سمراء، وملامح تملأ قلب: عندما تسير يتابعها من بعيد كلُ من يراها، خطوتها ممتلئة ثقة وكبرياء، وكان ” كريكور ” متعلَقاً بجدته كثيراً، يحبَها لأقصى درجات الحب، وحين توفيت الجدَة شعر بفراغ كبير وشعر بأنَ اليد التي احتوته قد ضاعت، كان يأخذ وردة كلَ يوم إلى جدَته لـ يضعا على قبرها، ويصلَي.
عادت أمل بذاكرتها يوم كانت بعملها في صالونها البسيط، وتذكرت كيف كانت تضع المساحيق على وجوه النساء كي تبرز جمالهنَ، تضع (الميكاب) الأسود على عيون العروس، لكنَ العروس طلبت أن يكون اللون رمادياً بتدرجاته، وهذا اللون قد نفذ، عند ذلك سمعت طرقاً خفيفاً على الباب، ووجدت ابنها أمامها، فطلبت منه أن يذهب ويأتي لها علبة فيها تدرَجات اللون الرمادي، يحاول الرفض لأنه يخجل، لكن الأم تلحَ عليه، فيذهب مجبراً، وهناك يجد الفتيات المراهقات يضحكن بنعومة عليه، وحين تؤنبه الأم على تأخيره، يجيبها: ” لقد جعلتني أضحوكة للفتيات، وقد كانت إحداهنَ تعجبني كثيراً”.
لم تدرك “أمل” ما عليها أن تفعل، أرادت أن تحتضنه وتقبله، أرادت أن تعتذر له، لم تستطع أن تمنحه حناناً وعطفاً كما كلُ الأمهات، مع أنَ بداخلها فيضاً من أمومة تودُ أن تمنحه لكن شيئاً ما يمنعها.
في طريق عودتها، تقرأ لافتة مكتوب عليها ” دير الكرمليت للراهبات” شيء ما يشدَها ويجعلها تطرق الباب، تفتح رئيسة الدير فتدرك أنها إحدى الزائرات لأولئك الموتى خلف سور الدير، دعتها للدخول ” تعالي ادخلي وشاركينا الصلاة ” رائحة البخور تملأ المكان، خمس راهبات كنَ جالسات على الأرض بخشوع يصلَين وكأنهن في عالم آخر، جلست مثلهنَ، نظرت إلى صورة العذراء مريم، وأخذت تصلَي بحرارة، أغمضت عينيها وعندما فتحتهما شعرت براحة كبيرة كأنها ريشة في الهواء، ربما رمت كلَ ثقل همها وحزنها هنا.
تمر الكاتبة على ” المعبر ” فتقول: ” إنَ أبناء حلب في حرب شوارع قذرة، حيث يكون القتال فيها في المناطق والشوارع المأهولة بالسكان، والأخطر أنهم يستخدمونهم دروعاَ بشرية، وحرب الشوارع تجعل أفراد الأسرة يخرجون من منزلهم صباحاً ولا يعلمون إن كانوا سيلتقون مساءً، أو أنَ أحدهم ستنال منه شظية أو رصاصة أو جرَة غاز يرميها أحد الإرهابيين فتحرق كلَ من تصادفه، وهم يحاصرون المدينة، يمنعون عنها دخول المواد الغذائية، تاركين طريقاَ واحداَ يسمونه ” المعبر” وتراهم عندما يعبرونه يركضون والخوف يعتلي قسمات وجوههم، ورعشات أجسادهم تزداد من قناص جالس يتسلَى في اصطياد ما استطاع من البشر خاطروا بحياتهم من أجل لقمة العيش لأولادهم، وقد قتل الكثير ، وكم من أكياس تهاوى ما بداخلها من خبز وطعام على شارع مليء بالحفر والتراب، اسمه: المعبر.
وتقرَر الكاتبة أن تخوض غمار التجربة، فتذهب إلى مجتمع ” الرَقة ” بواسطة ” هناء ” لقد انضم أحمد إلى تنظيم (داعش) ويطلب من أمه وأخيه وزوجته وأولاده أن يتوجهوا إلى الرقة، وبسبب الحصار الاقتصادي، يضطرون إلى الذهاب، وترينا الكاتبة سوء معاملتهم لهناء بعد موت زوجها، فأخو زوجها يستغلَ ولدها بأن يسجله في التنظيم، كذلك يستغل هناء بأن يزوَجها لأحد المقاتلين، مما يجبرها على الهرب إلى منطقة الجيش النظامي والعودة إلى حلب، وتعيش بين أهلها، ويعلمهم جدهم أصول المحبة والتسامح التي جاء بها الإسلام.
تعود الكاتبة لتذكر لنا شهيداَ آخر، إنَه ” جورج ” ويأتي الخبر إلى ” جانيت” عندما تعلم باستشهاده وقد طلب أن يدفن في حلب عند أهله، وعندما قرَروا دفنه، فتحوا الصندوق لتكتشف جانيت أنَ ابتسامة على ثغره وثقب في رقبته، وهنا علمت أنه تمَ قنصه، حينذاك أغلقوا الصندوق ونثرت النساء الأرز والورد على الصندوق الملفوف بالعلم السوري الذي يحمله أصدقاؤه وهم يرقصون به في زفة عريس.
ونعود إلى أمل التي استجابت لدعوة سيدة الياسمين، فقد كانت تلتقي بكلَ عائلة على التوالي، كانت أمل تتحدث إليها عن ولدها الشهيد وكيفية استشهاده، وأخذت السيدة تحدثهم عن قيمة وأهمية ما قدَمه ابنهم كريكور لحماية وطنه وأرضه، وأجابتها أمل بأنه قدَم ذاته من أجل بلده بكامل إرادته وأنها فخورة بذلك ومستعدَة لتقديم ولدها الثاني فداء لسورية.
عندما دخلوا إلى غرفهم وجدوا هدايا بسيطة لكلَ العائلات من السيدة: هاتف محمول، جهاز كمبيوتر، وظرف به مبلغ مادي.
تلتقط الكاتبة عدَة نماذج من النساء، لهنَ مشاكل اجتماعية، فتعالجها بتقديم ظرف فيه مبلغ مالي، ومكتوب عليه ” مني أنا كريكور إليكم، كلَ ما أطلبه الرحمة على روحي، مع كلَ حبي”.
نذرت أمل منذ زمن طويل أنها لن تخلع السواد إلا يوم تحرير حلب، الآن حيث تمَ تحرير المدينة، فخلعت السواد وارتدت الأبيض، ومما زاد من فرحها أنها ستقوم بنقل جثمان ابنها إلى مكان يليق به، وبعد أسبوعين تذهب إلى مدرسة الشهيد كريكور، هذا هو اسم ابنها قطعة من روحها وقلبها.
شخصيات من الواقع، اختارتها الكاتبة لتعبَر عن المأساة التي سببتها الحرب، واختارت لهنَ هذه الحياة ليتفاعلن معها ويعشن جحيم الحرب، الزمان هو يوميات الحرب على سورية أما المكان فهو المدن السورية، وبخاصة الرَقة ودمشق وحلب.