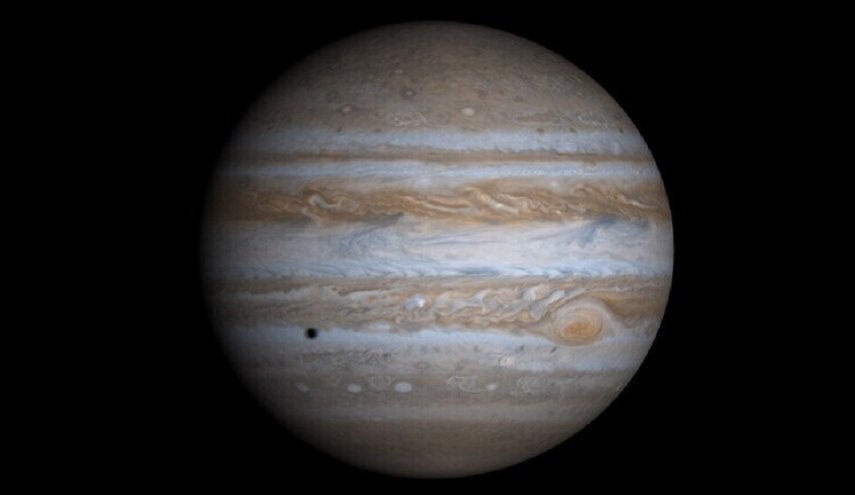المسرح..وجمهوره!!
بعيدا عن أماكن تواجد (المثقفين) في دمشق، عن المقاهي وجلسات النميمة الثقافية المعتادة، وفي الأماكن الأكثر اكتظاظا بالناس كسوق الحميدية الشهير، باب سريجة، ساروجا، حدث أن توجهنا إلى الشريجة الأوسع من الجمهور السوري، لنسأله عن علاقته بالمسرح، السؤال الذي يتفرع منه عدة أسئلة، مثل: ما هو آخر عرض مسرحي حضرته؟ من تعرف من كبار المشتغلين في المسرح؟ هل تذهب إلى المسرح؟، وغيرها من الأسئلة التي تدور في فلك وعمق المسرح وعلاقة الجمهور به، الإجابة متوقعة عموما كما أنها ليست صادمة، وللإنصاف، الإجابات جاءت متباينة جدا، ومنها ما هو متطرف حتى اللحظة حيال هذا الفن الفلكلوري شئنا أم أبينا على الأقل في الشكل الذي يعتبره “الشكلانيون الروس”، هو الأهم في العمل الفني أو الأدبي، فالمواضيع أو الثيمات التي يقدمها فن المسرح، متشابهة جدا، وهي متنوعة وغنية، منها ما تم استهلاكه حتى تحول إلى كليشيه، ومنها ما اندثر وقتها، ولم تعد مناسبة لمفردات العصر، إلا إن كانت تُقدم مفردات ذلك العصر بحبر اليوم.
في شوارع مختلفة من دمشق حيث الناس، دار حديث عن هذا، عن علاقتهم بالمسرح، كيف يرونه، وماهي معرفتهم به عموما، وغيرها من الجوانب المتعلقة بأبي الفنون كما يُسمى!
السيدة “مايا” ذهبت رأسا نحو خلل حدث في علاقتها بالمسرح، وعنه تقول: “لم اعد أذكر متى كان آخر عرض مسرحي شاهدته، لكنني عموما استطيع أن أقول أن المسرح لم يعد كما كان سابقا، لا فكرة، لا إخراج، لا تمثيل، مثلا اليوم اغلب الأعمال المسرحية توجهت نحو الواقع المحلي، لكن ما قدمته، كان الواقع قد سبقها إليه، عدا عن كونها تمعن في تقديم مقاطع من الواقع، وتقدم شخصياته بذل، وهذا ما يجب أن يتم الابتعاد عنه، نحن نريد أن نشاهد ما يرتقي بالوعي العام، لا نريد أن نشاهد ما يكرس الإسفاف فيه، وهذه حالة خطيرة في الفنون عموما، فالآن مثلا ما من مرة تم عرض “كاسك يا وطن” إلا وشاهدتها، العرض الذي مرّ عليه قرابة ال 40 عاما، ولا يزال طازجا نابضا عدا عن كونه في بعض مفاصله جاء “تنبؤيا” وهذه قيمة كاتب مسرحي ثقيل مثل محمد الماغوط، لقد تنبأ بأعماله و”منها كاسك يا وطن”، بما يجري اليوم، منذ مدة قريبة كان رجلا في مدينة حلب، يحمل طفليه، وعلى ظهر كل منهما كتب “طفل للبيع، ألم نرى هذا في ذاك العمل؟”.
تناولت مايا شربة ماء وتابعت: “اليوم للأسف نسبة كبيرة من الحضور، هم من أصحاب الوقت الفائض عن حاجتهم، يشغلونه بحضور عرض مسرحي هنا، أو فيلم سينمائي هناك، وهذا يدل على وجود مشكلة عميقة مع فهم الناس عموما للفن وخصوصا المسرح، بالماضي كنا على الأقل نفهم ما يجري على الخشبة، اليوم تحتاج محلل شيفرات ورموز يخبرك ماهي الحكاية التي تراها، هذا عدا عن الانعدام شبه التام للنقد المسرحي، فكيف لفن أن يستمر دون يكون هناك من يُقيّمه، ويحدد ضوابط عامة له، وإلا كيف سيعرف أن هذا الفن الاستمرار، النقد الفني هو الوجه الآخر للعمل الفني، ولكن هذا غائب عندنا للأسف، ثم كيف يذهب نحو النصوص العالمية، والحياة اليومية السورية مليئة بالحكايات، إنها على الأرصفة، وفي البيوت، في الأسواق الكبيرة منها والصغيرة، في سيارات الأجرة وبين عنابر المشافي، ثم تذهب إلى عرض مسرحي، لتهم بالخروج بعد ربع ساعة بالكثير من بدايته وأنت تكاد تصيح: بالله عليكم ما هذا”، أما عن آخر عرض حضرته فكان للفنان”أيمن زيدان” ووصفته بالعرض الفاشل.
الشاب سامر الحمصي، عامل في سوق الخجا، بين مقر عمله ومسرح القباني “عضة كوساية” كما يُقال، لكنه يوما ما، لم يفكر حتى مجرد تفكير بالذهاب إلى المسرح، وعن هذا يقول: “لم اذهب في حياتي، ولن أذهب”، وأسأله لماذا؟ هل ذهبت ولم يعجبك الحال؟ أم ماذا؟ ليجيب: “شاهدت مسرحيات غوار على التلفزيون، وهو أحسن شي، مرة ذهب أحد أصدقائنا مع صديقته لحضور عرض مسرحي وعندما سألناه ماذا شاهد، كان جوابه بأنه لم يفهم أي شيء مما جرى، ولولا عيون صديقته لهرب منذ بداية العرض”. سامر مُصر على رأيه، لن يحضر عرضا مسرحيا، فهو لا يحب هذا الفن إلا على التلفزيون!
أبو ياسين -55-عاما: “لم يحدث أن ذهبت لا في سن الشباب ولا فيما تلاه من السنين إلى المسرح”، وعن السبب قال: “لست فاضيا، أنا رجل اعمل 20 ساعة تقريبا في اليوم لأحصل على قوت عيالي”، وعن آخر ما شاهده من عروض مسرحية على التلفاز أجاب بلهجته الشامية الظريفة “هي المشاغبين وغوار ما غوار وهدول الشغلات”، وعندما سألناه عن المسرح القومي، وعن عدة أسماء مسرحية سورية وعالمية، قال “الماغوط كاتب كبير، غربة وما غربة، وكاسك يا وطن، وهي أعمال شاهدتها على التلفاز، غير هيك ما بعرف حدا”. أبو ياسين لا مشكلة لديه أن يذهب أولاده إلى المسرح الذي لم يعرفه يوما إلا على التلفاز.
في الحقيقية وكما أسلفت الأجوبة لم تكن صادمة، إن كان عُشاق هذا الفن لا يجدون فيه ما يشفي شغفهم، فما بالنا بالناس التي لا تعرف عن الحياة إلا العمل المضنِي من الفجر إلى النجر.
هناك أيضا بعض النماذج التي حاورناها عن ذات الشأن، وجوابها “لا فتت ولا بدي فوت”، فعن أي جمهور مسرحي إذا نتحدث؟ عن أصحاب بطاقات الدعوة الجاهزة وربطات العنق المتبرمة؟ هؤلاء الناس، في الشارع، في المحال التجارية، في الصيدليات، على عتبات المشافي، وغيرها من الأماكن، يسمعون بالمسرح، ولا يعنيهم بشيء، وفي حال أردنا القول إن الجمهور يختلف عن الحشود، فإننا بذلك نعترف ونقرّ، بكون المسرح فنا لا جماهيريا، فنا نخبويا حتى التخمة، أما عن “الحشود”، فهي تحفظ كل اسم ورد في المسرحيات المتلفزة التي مضى عليها أكثر من 40 عاما، ولا زالت حتى اليوم تحرك لهفته.
تمّام علي بركات