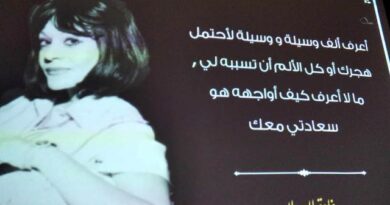شُرفـــــة نقديّــــة
عبد الكريم الناعم
من البدهيّ أنّ النّقد يلعب دوراً نوعيّا في كشف ما في النصّ من جماليات صريحة، وإضمارات مُلوَّح بها، بعيدا عن الإبهام الذي هو إمّا دليل عجز، أو أنّه خيار غير موفَّق، ربّما، جرياً وراء أوهام حداثويّة، ولعلّه من الجدير بالملاحظة، والتوقّف المتأنّي أنّ أفضل ماقرأناه من نقد جاد، واضح لاغموض ولا تغميض فيه، كان في فترات صعود المدّ الوطني القومي، التقدّمي، والأمثلة أكثر من أن تُحصَر.
الآن ثمّة تراجع مُخيف في أثر النّقد، لغيابه من جهة، ولفقدان المنابر التي تشكّل الفضاء الطبيعي الفاعل لنموّ تلك النّبتة، ويترافق هذا، لكلّ ذي نظر، مع انكسار المشروع الوطني القومي التقدّمي الديمقراطي، كما ترافق مع تدنّي المستويات التي يُطلَق عليها أنّها أدبيّة، فلم يعدْ الوصول صعبا إلى منابر المراكز الثقافيّة، أو المنابر التي يقيمها بعض الرّاغبين، بدوافع عدّة، وصرنا نقرأ عن العديد من الأمسيات المزدحمة في تلك المنابر لأناس، في غالبيّتهم يجهلون مبادئ الكتابة السليمة، وهم لم يتزوّدوا ثقافيّا بما يكفي لتتشكّل عندهم خميرة إبداعيّة مقبولة، فاختلط الغثّ السائد بقليل من المواهب الواعدة، بالشعر الزّجلي، الذي أرى أنّ الجيّد منه يُفترَض أن تُقام له أمسياته الخاصّة، وزاد الطين الكثير من البلَل أنّ القيّمين على تلك المنابر الثقافيّة، في معظمهم لا يفرّقون، ثقافيّا بين “طاها وإنطاكية” كما يقول المثل الشعبيّ!
بعد هذا الإجمال سأذهب باتّجاه مسألة أراها من المسائل الهامّة في النّقد، وهي أنّ معظم النّقّاد المعاصرين، أو المتطفّلين على النقد، والمتصدّين لنقد الشعر، هم، في الغالبيّة أيضا، ممّن لا يتمتّعون بأذن موسيقيّة إيقاعيّة وزنيّة، وأعني ما سمّاه الدكتور إبراهيم أنيس “الوزن القومي” تحديدا، ولذا تراهم لا ينتبهون إلى القيمة الجماليّة والنفسيّة والتعبيريّة لإيقاع القصيدة، بعيدا عن أوهام الإيقاعات الداخليّة التي يتلطّى وراءها البعض.
النقّاد القُدامى في تاريخنا الأدبي، والذين اهتمّوا بنقد الشعر كانوا في الغالب ممّن يجيدون كتابة الشعر الموزون، بغضّ النّظر عن قيمة ما كتبوه من النّاحية الإبداعيّة، وهذا جعلهم أكثر قدرة على تلمّس بعض الملامح الجماليّة، الآن نرى العكس، فعلى الرّغم من أنّ التفعيلات التي نكتب بها الآن لا تتجاوز الثمان، بعد أنْ كانت تتجاوز الخمسين، بين إيقاع تامّ، ومجزوء، ومنهوك، فما ثمّة مَن يحفل بهذا الأمر، وفي ذلك إسقاط، لقيمة جماليّة إيقاعيّة، يمكن لمتتبّعها، إذا كان ممّن يمتلكون الموهبة الإيقاعيّة، أن يبحث عن الكوامن الإبداعيّة الخفيّة التي جعلت الشاعر يختار هذا الإيقاع لهذه القصيدة.
قلت للناقد المتميّز الرّاحل يوسف سامي اليوسف في جلسة جمعتْنا إنّك تكتب النّقد الشعري بروح شاعر، فضحك وقال “لقد بدأت شاعراً، ونشرت إحدى قصائدي في مجلّة “ألآداب” اللبنانيّة عام 1958″، فحضرتْ في ذهني مقولة أنّ خير نقّاد الشعر هم الشعراء الذين يمتلكون أدوات النّقد.
إنّ ما سبق يذكّرنا بمقولة أنّ في داخل كلّ شاعر ناقد، موجود بطريقة ما، وحساسية هذا النّاقد الشعريّة هي التي تجعله يفضّل مفردة على أخرى، وهي ذاتها التي تُجيد ربط أواصر القصيدة، وحبْكها، وزخرفتَها، وتلوينها، لتخرج في أجمل ثوب من ثياب ذلك النسيج.
إنّ عدم الانتباه إلى أهميّة الإيقاعات الشعريّة يُعتبَر خسارة، تراكمتْ، وستظلّ تتراكم، حدّ أننّا لم نعد نأبه بهذه الخصيصة الجماليّة!.
أثير ما أثرتْ وأنا شبه يائس من الخروج من هذا المطبّ، لأسباب كثيرة، ليس هذا مجالها، بل ونُواجه، وهو العاجز عن كتابة بيت واحد من الشعر الموزون/ الموقّع، وهو يتعالى على هذه الدعوة الإيقاعيّة المتخلّفة!! ولعلّني أراهن رهانَ من قلّ أملُه، في أن يكون لتجاوز الخراب الذي عمّ وطمّ، ما يشكّل بداية للخروج من ذلك النّفق.
أكاد أرى الذين يُنغضون رؤوسهم من غير الآبهين، وأكاد أرى ضحكاتهم الصفراء، ولكنّ هذا لن يغيّر من الأمر شيئا، بل هو، كما أفترض، يثير التحدّي لدى الذين يتحسّسون قيمة الإيقاع الوزنيّة أن يمتلكوا الجرأة في الكتابة في هذا المجال، لترسيخ المقولة، ولفتْح آفاق جديدة، دون خشية من جيوش المتسلّقين، والمتأدّبين، والواصلين إلى منابر أدبيّة لا بإبداعاتهم، بل بوسائل لا علاقة لها بالإبداع..