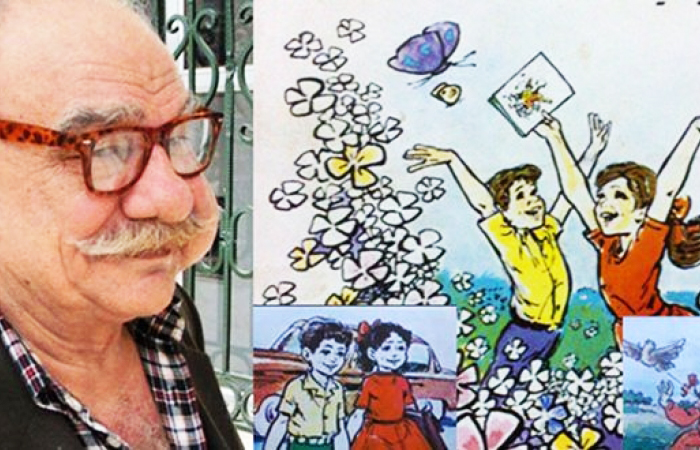بهدف شيطنة سورية وروسيا.. المكارثية الإعلامية تسيطر على المنصات الليبرالية اليسارية
“البعث الأسبوعية” ــ علي اليوسف
إن إحدى المهام التي تستلزم الصحافة المعتدلة، أو الحيادية، هي التشكيك في الروايات الرسمية التي تطرحها وكالات الاستخبارات وخبراء السياسة الخارجية الذين يحافظون على استمرار الإمبراطورية الأمريكية، بغض النظر عن المكاسب الحزبية أو المهنية.
وبمراجعة بسيطة للحقائق سيتبين ما كانت تكذب بشأنه وسائل الإعلام والصحافة الغربية التابعة للولايات المتحدة. على سبيل المثال، في نيسان 2018، قصفت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا سورية بعد اتهام الحكومة بارتكاب هجوم كيماوي في دوما، لكن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذين زاروا الموقع بعد أيام لم يجدوا أي دليل على هجوم بالأسلحة الكيماوية في دوما؛ كما أظهرت مجموعة من الوثائق المسربة، بما في ذلك التقرير الأولي للفريق الذي تم إخفاؤه، أن النتائج التي توصلوا إليها تم التلاعب بها وإخفائها عن الجمهور.
بعد الاحتجاج الداخلي في المنظمة على هذا التلاعب، قامت مجموعة من المسؤولين الأمريكيين بزيارة لاهاي، وفي خطوة غير أخلاقية، حاولت إقناع فريق التفتيش باستبدال “استخدام الأسلحة الكيميائية” بـ “استخدام غاز الكلور”. وليس هذا فقط، فقد تم إخراج المفتشين من القضية واستبدالهم بمجموعة لم تطأ أقدامها سورية أبداً، حيث خرج التقرير النهائي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي صدر في آذار 2019، بما يتماشى مع رواية الولايات المتحدة في الادعاء باحتمال وقوع هجوم بالكلور، ما أدى إلى تشويه أو حذف الأدلة التي جمعها المفتشون الأصليون.
لهذا، شكل رفض وسائل الإعلام الأمريكية تغطية قصة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحد أفظع حالات العمى المتعمد والرقابة الذاتية على الصحافة منذ الفترة التي سبقت حرب العراق. إنهم لا يقومون فقط بغطاء لإثارة الحروب التي يزعمون أنهم يكرهونها، بل يتخلون أيضاً عن المخبرين الشجعان من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذين تحدوا التستر على مخاطرة شخصية كبيرة. والأسوأ من ذلك أنهم يحرمون ضحايا دوما من العدالة، والذين لا يزال سبب موتهم الفعلي مجهولاً.
لا يحتاج المرء إلى الكثير لاكتشاف الدرجة العالية من التلفيقات، وإن إلقاء نظرة سريعة على الإنتاج الصحفي لـوسائل الإعلام، ومن يمولها، أمر مفيد. وعلى سبيل المثال، تقوم العديد من وسائل الإعلام بتغطية مؤتمرات الناتو، وهي جميعها تظهر أن دورها مجرد “تغطية صحفية”، أما الحقيقة فإن عملها ترويجي لدعم عمليات الناتو.
وعليه، أفسدت مكارثية الإعلام بشكل فيروسي العقول حتى عبر وسائل الإعلام الليبرالية اليسارية في السنوات الأخيرة، وكان الدافع وراء هذا الطاعون الأيديولوجي هو حملة دعائية متقنة بهدف محدد هو شيطنة روسيا وسورية. وبإتباع نفس قواعد اللعبة المستخدمة في العراق وليبيا، وأي هدف آخر للهيمنة الأمريكية، فإن هذه الحملة تختزل دولاً وشعوبا بأكملها في صورة كاريكاتورية لقادتها، بينما تبرر الكراهية أو العدوان الصريح ضدهم بمناشدات ساخرة مثل حقوق الإنسان والديمقراطية. وما يميز قضيتي روسيا وسورية عن بعضهما البعض هو مدى نجاح جهود التضليل هذه في تجنيد الإعلام اليساري للتأثير المباشر على مواطني روسيا وسورية، أي أن هذا الإعلام استهدف بشكل مباشر ديمغرافية البلدين.
حالة سورية
في حالة سورية، كانت الرواية السائدة التي تم بيعها للعالم هي نشر الديمقراطية، لكن في الواقع تعرضت سورية لواحدة من أكثر الحروب القذرة تكلفة وتدميرا وفتكا في التاريخ.
لا علاقة للحرب القذرة على سورية بالمظاهرات التي انطلقت في بداية ما يسمى “الربيع العربي”، فقد تم احتواء هذه المظاهرات واستغلالها من قبل قوى خارجية – الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وقطر والمملكة المتحدة وإسرائيل – التي شنت في الوقت نفسه حرباً إجرامية مخططا لها مسبقاً تهدف إلى إسقاط أهم دولة في “محور المقاومة”. وهذه الحقائق متاحة الآن بسهولة لأي شخص يرغب في استيعابها، ومن أكثر المصادر شيوعاً، ومن اعترافات المدراء المعنيين العامة والخاصة.
وكما تقول الرواية الرسمية الأمريكية، فإن الأسلحة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى سورية، بموجب برنامج “خشب الجميز” – برنامج سري لتوريد الأسلحة والتدريب تديره الولايات المتحدة الأمريكية، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وبدعم من بعض أجهزة المخابرات العربية، تم إطلاقه في 2012 – 2013 لمحاربة الرئيس بشار الأسد- كان من المفترض أن تكون مخصصة لما أسمته أمريكا “معارضة معتدلة”، لكن لم يفضح أحد هذه الأسطورة بإيجاز أكثر من شاغل المكتب البيضاوي الحالي. ففي ملاحظة مميزة خارج النص إلى جمهور من جامعة هارفارد، في عام 2014، أقر جو بايدن بأنه لا توجد “معارضة معتدلة” في سورية. وبدلاً من ذلك، قال بايدن: “إن حلفاء الولايات المتحدة في سورية ضخوا مئات الملايين من الدولارات وآلاف الأطنان من الأسلحة لكل من سيقاتل ضد الرئيس بشار الأسد”. إلا أن الأشخاص الذين تم دعمهم هم “النصرة” و”القاعدة”، والعناصر المتطرفة من الإرهابيين القادمين من أنحاء أخرى من العالم”. وأوضح بايدن أن هذا هو السبب في أن “حلفاءنا في المنطقة كانوا أكبر مشكلة لنا في سورية”.
سرعان ما اعتذر بايدن عن الإساءة إلى حلفائه الخليجيين والأتراك. لكن خطأه الوحيد – بصرف النظر عن عدم ذكره اسم قطر – كان حذف حقيقة أن الولايات المتحدة كانت شريكاً راغباً لهم، واستمراراً لعلاقة العمل السابقة في الحروب القذرة في نيكاراغوا وأفغانستان.
تمكنت الحكومة السورية وحلفائها في نهاية المطاف من هزيمة “الكونترا” الطائفية المدعومة من الولايات المتحدة واستعادة السيطرة على أجزاء كبيرة من البلاد. لكن الضرر كان لا يحصى: القدرة الصناعية والزراعية هلكت. والدولة التي كانت تتمتع في السابق ببعض من أعلى مستويات الإنتاج الطبي والتعليمي والغذائي في الشرق الأوسط، تُركت منقسمة وجائعة وفقيرة.
ومنذ هزيمتها العسكرية، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها سياسة أخرى من سياساتها التدخلية، وهي خنق الشعب السوري بحرب اقتصادية. وفي الوقت الذي تحاول فيه سورية إعادة البناء، يحتل الجيش الأمريكي ثلث سورية، ما يحرمها من الوصول إلى منطقة غنية بالموارد تحتوي على احتياطيات نفطية حيوية وقمح، كما يتفاخر المسؤولون الأمريكيون صراحة. وفي صيف عام 2020، فرضت إدارة ترامب جولة جديدة من العقوبات المشددة بموجب قانون “قيصر” من الحزبين، وتستهدف هذه العقوبات بشكل صريح إعادة الإعمار، وقد أدت، على حد تعبير مبعوث ترامب جيمس جيفري، إلى “تدمير اقتصاد البلاد”.
وبدلاً من تحدي حملة الإرهاب العسكري والاقتصادي المستمرة التي شنتها حكوماتهم على مدى عقد من الزمان في سورية، ظهرت مجموعة من الأكاديميين والشخصيات الإعلامية والصحفيين الغربيين لمناصرة هذه الحملة. وباسم الدفاع عن “الثورة السورية”، روجت هذه الأصوات للشوفينية الغربية وتبييض عواقبها الكارثية على الشعب السوري. لذلك فإن ادعاء الترويج للديمقراطية هو أمر سخيف، حيث لم يصوت أي سوري لدول حلف شمال الأطلسي التي تتصرف كدكتاتورية عالمية، وتتعهد لنفسها بالحق في تدمير دولة أجنبية عن طريق تمويل وتسليح وتدريب جيش ضخم من الوكلاء الإرهابيين.
ولإخفاء هذا الواقع، بذل المدافعون الغربيون “اليساريون” عن الحرب القذرة في سورية جهوداً كبيرة لمحو الدور الأمريكي المدمر. وتنديداً لما أسموه “معاداة الحمقى للإمبريالية”، أعلن صحفيون وأكاديميون أن واشنطن ظلت بعيدة عن الأضواء في الحرب السورية، لكنها بدأت تصعيد تدخلها فقط بعد أن اندفع ما يسمى “داعش” عبر الحدود إلى العراق، وبعد ذلك بدأت “حصر تدخلها المباشر في القتال ضد داعش”.
هذه الرواية – القتال ضد داعش- كانت الخبر المهم لصانعي السياسة فيها، الذين استهدفوا سورية بأحد أكثر برامج العمل السرية تكلفة في تاريخ وكالة المخابرات المركزية، كما قالت “نيويورك تايمز”، بالاعتماد على ميزانية تقترب من مليار دولار في السنة.
صحيح أن إدارة أوباما قصفت المناطق التي يسيطر عليها “داعش” في سورية، لكن من الصحيح أيضاً أن الولايات المتحدة استفادت عن عمد من تقدم “داعش” لتحقيق أهداف تغيير النظام. تم التنازل عن ذلك، بشكل خاص في عام 2016، من قبل وزير الخارجية، آنذاك، جون كيري، الذي أخبر مجموعة من نشطاء “المعارضة السورية” أن الولايات المتحدة تجلس في أعقابهم لأن “داعش” تزداد قوة، وربما تزحف إلى دمشق. وأوضح كيري: “كنا نراقب. رأينا أن داعش تزداد قوة، وكنا نعتقد أن الدولة السورية مهددة”. وأضاف كيري أن اللامبالاة الأمريكية تجاه خطر استيلاء “داعش” على السلطة هو سبب دخول روسيا إلى سورية في عام 2015 لأنهم لا يريدون حكومة داعش”.
إذا كان هناك أي شيء غير ظاهر حول هذه الحرب القذرة المكلفة والسرية والقاتلة، التي تقودها وكالة المخابرات المركزية، فإن الطريقة التي تم بها إخفاء الحقائق الأساسية عن الجمهور الغربي هي التي مولتها؛ ويرجع الفضل في جزء منه إلى الدعاة مثل هؤلاء الصحفيين والأكاديميين الذين يستمرون في إعطائها الغطاء. كان التقليل من شأن دور واشنطن له طابعه الخاص تماماً، فبالإضافة إلى تبييض الحرب القذرة على سورية، جرى حث الصحفيين اليساريين على الوقوف في الصف وراء تدمير الناتو لليبيا.
إن الحرب القذرة على سورية هي من أكثر التدخلات الغربية فتكاً في الذاكرة الحديثة، وهي تُظهر إلى أي مدى أدت حملة الدعاية ضد سورية إلى الشوفينية وإخفاء عواقبها المدمرة على السكان المستهدفين. والآن، مع قيام الولايات المتحدة بالضغط على الشعب السوري بأقسى العقوبات في العالم، لا توجد حملة أمريكية منظمة كبرى لوقفها، ولا حتى أي منفذ تقدمي كبير على استعداد لتغطيتها. وحتى هؤلاء الذين رفعوا شعار “نشر الديمقراطية” الذي غطى العقوبات الأمريكية المدمرة على العراق في التسعينيات، التزموا الصمت بشأن العقوبات الأمريكية على سورية، كما فعلوا مع فضيحة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. إنها قسوة محضة، ولا يوجد تحرك لوقف العقوبات الأمريكية التي تدمر حياة السوريين العاديين، لأن الجميع يعلم أن هذه العقوبات هي لغرض وحيد هو معاقبة سورية على هزيمة فرق الموت المدعومة من الولايات المتحدة والخليج.
اليوم، وبعد عقد من الحرب التي غذاها مخطط غربي لتغيير النظام، يعاني الشعب السوري ضائقة اقتصادية كبيرة جداً. ومع ذلك، يستمر صانعو السياسة الغربيون في معاقبة البلاد بفرض عقوبات على التجويع.
حالة روسيا
أدت الموافقة على الحرب القذرة على سورية إلى تمهيد الطريق لتعزيز حالة العداء ضد روسيا، وتعزيز فكرة “الهوس الروسي” الذي استهلك السياسة الأمريكية، ابتداءً من عام 2016. ومنذ ذلك الحين، تم تصوير روسيا تحت حكم فلاديمير بوتين على أنها التهديد الوحيد للولايات المتحدة. وحينها صرح السيناتور ميت رومني أن روسيا “عدونا الجيوسياسي الأول”. سخر الديمقراطيون من رومني في ذلك الوقت، لكن مصطلحه – عدونا الجيوسياسي الأول – أصبح منذ ذلك الحين عقيدة ليبرالية.
وثق الباحث الراحل ستيفن كوهين أن أسباب العداء الغربي تجاه بوتين تعود جميعها إلى تمرده على الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة، ومنها كبح ملكية الولايات المتحدة لصناعة النفط الروسية، والتقليل من النزعة العسكرية الأمريكية حول العالم، وهزيمة جورجيا بسهولة في نزاع عسكري عام 2008، وإهانة المحافظين الجدد مثل ماكين الذي حرض على ذلك النزاع، ومقاومة انقلاب “ميدان” المدعوم من الولايات المتحدة، واستعادة شبه جزيرة القرم، وبالتالي إضعاف خطط المحافظين الجدد لإقامة دولة في الناتو على حدود روسيا؛ وعلى نفس القدر من التحدي، كان دخوله سورية إلى جانب الحكومة للمساعدة في هزيمة فرق الموت الوهابية المدعومة من الولايات المتحدة، لأن روسيا، كما اعترف جون كيري سراً، “لم تكن تريد حكومة داعش”.
مهدت هذه الخلفية المسرح لشيطنة روسيا، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016، عندما زُعم أن روسيا شنت حملة تأثير “كاسحة ومنهجية” لتنصيب ترامب في البيت الأبيض.
أصبحت دوافع “روسيا غيت” الآن واضحة المعالم، وهي إلقاء اللوم على روسيا، وتحميلها مسؤولية مؤامرة وتواطؤ خيالية كانت من نتائجها إبعاد النخب الديمقراطية الليبرالية وهزيمتها المهينة أمام ترامب. تلاقت المصلحة الذاتية الحزبية للديمقراطيين مع مصالح دولة الأمن القومي القوية التي اعتبرت ترامب المتحدث بصوت عالٍ وكيلاً غير لائق لآلة الحرب الأمريكية العالمية. سعى هؤلاء المسؤولون أيضاً إلى وصم جاذبية رسائل حملة ترامب المناهضة للتدخل لعام 2016، على أنها مخادعة مثل هذا الخطاب. وقد جاء اعتراف ترامب الصريح بأن الحرب الأمريكية القذرة على سورية قد مكّنت تنظيم “القاعدة”، ودعوته إلى التعاون مع روسيا، بمثابة هرطقة لمؤسسة السياسة الخارجية من الحزبين، والمكرسة بشدة للحرب القذرة في سورية، وحرب باردة جديدة في كل مكان آخر.
من جانبها، كانت الآلة الإعلامية الأمريكية أكثر من سعيدة بإلقاء اللوم على “المتسللين” الروس الذين دعموا ترامب، وساعدوه في الوصول إلى السلطة. كانت كل مراكز القوة هذه أكثر من سعيدة بالتركيز – إلى ما لا نهاية – على الأوليغارشية الروسية، على عكس الأوليغارشية الأمريكية التي تدير كلا الحزبين السياسيين، أي شبكات الإعلام، والشركات الكبرى والكونغرس.
وكما هو الحال مع الحرب القذرة في سورية، أنتجت حملات التضليل ضد روسيا سلسلة لا نهاية لها من الكتابات – الإعلام اليساري – لتعزيز “شيطنة” روسيا. لكن النتيجة كانت كارثة على اليسار، فقد تم استخدام “روسيا غيت” بتوسيع الاحتضان الليبرالي لوكالة المخابرات المركزية، ودولة الأمن القومي الأمريكية. وكان من أشهر المنصات الإعلامية التقدمية الرئيسية في البلاد ( ذا انترسبت- الديمقراطية الآن- مزر جونز- ذا ينغ توركس ) وهي جميعها دأبت على تكرار مزاعم مسؤولي المخابرات الأمريكية الخالية من الأدلة، والكتابة عن تحولات المؤامرة التي روجها منظرو مؤامرة ترامب وروسيا.
مع مرور الأيام، تعرضت وسائل الإعلام الليبرالية للإذلال عندما انهارت نظرية المؤامرة الروسية في النهاية، كما تعرضت لضربة موجعة ثانية عندما افتضاح الدور التخريبي للولايات المتحدة في سورية. لذلك من المحبط رؤية الصحفيين المعتدلين إما صامتين، أو حتى يتم خداعهم من قبل حملة التضليل، وهم مستمرون في ذلك رغم أن الأضرار التي لحقت بسورية من الحرب القذرة التي تدعمها الولايات المتحدة لا تُحصى. ورغم ذلك، لا تزال المنصات الإعلامية التقدمية واليسارية متمسكة بالدعاية الكاذبة ضد سورية وروسيا التي لم تكن مدمرة فحسب، بل وتشير أيضاً إلى قوة نظام الدعاية الأمريكية ومرونة وسائل الإعلام الانتهازية.