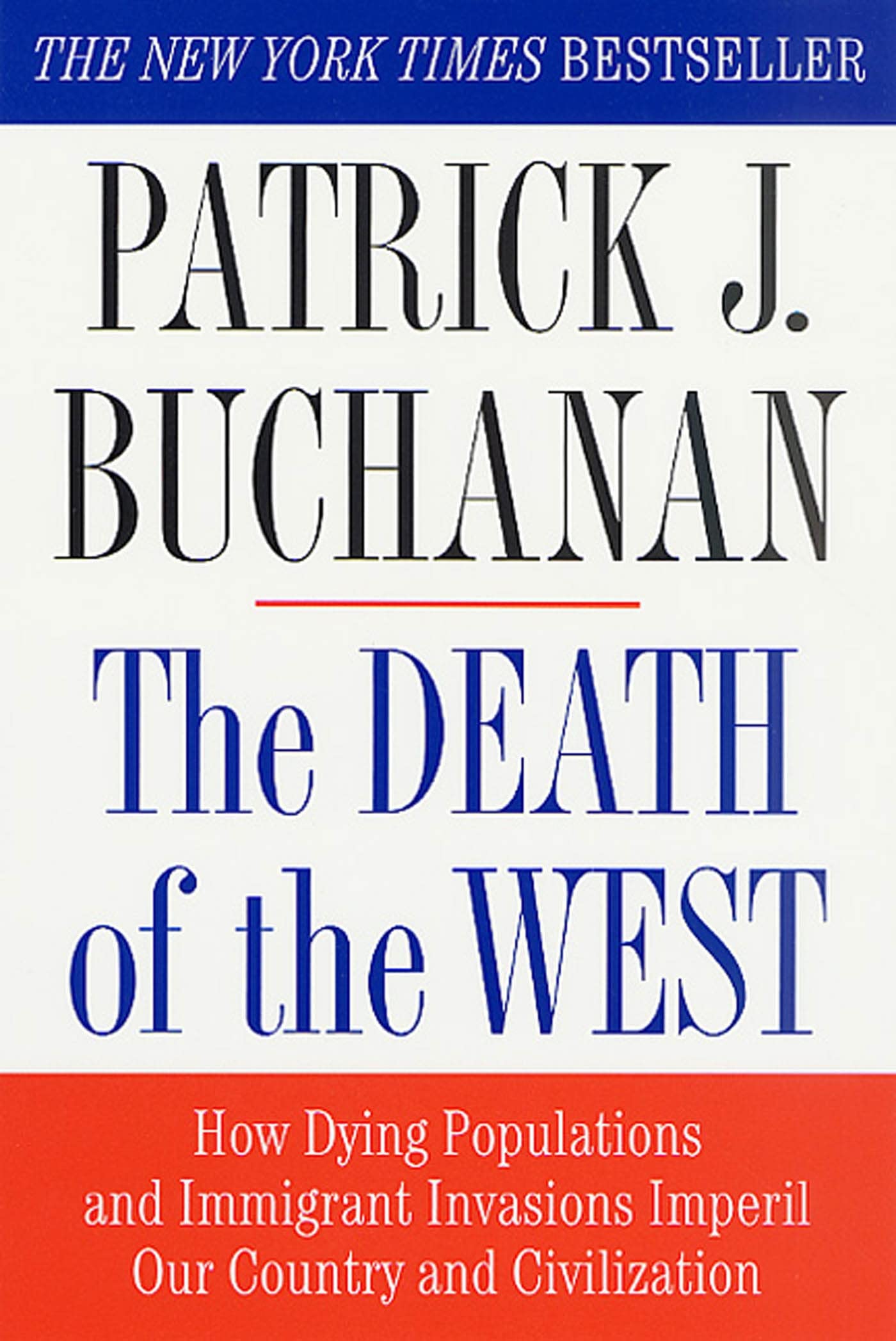ناس ومطارح.. مصطفى علي: منحته اللاذقية الحياة، وألبسته دمشق قميص محبتها المشجر
تمّام بركات
صفة “العالمي” الملحقة به، وحياته التي توزعت بين اللاذقية، دمشق، فرنسا، إيطاليا، لم تستطع أن تتنزع طين الطمي الذي كان يلهو به طفلاً، من تحت أظافره ومن بين شغاف قلبه أيضاً، كما أنها لم تقدر على تغيير ملامح الفتى الريفي، المحفورة في دمه، والتي لا زالت بادية على محياه، حتى وهو يقترب من سن الـ”70″ فالنحات العالمي مصطفى علي -1956- ابن “أوغاريت” في مدينة اللاذقية، يؤمن أن الإنسان ابن بيئته، مهما ابتعد عنها، حتى وإن غدت مفرداتها كما لو أنها حلم بعيد، أو شكوك لا تحتمل التأكيد إلا لجهة الروح، عن وجودها أساساً.
ومن جوار رمال شاطئ “أوغاريت” من بين أشجار الليمون وعبقها المشبع للحنين والمحرض عليه، راحت حيات مصطفى علي تأخذ بعداً مختلفاً، وراح هو أيضاً يتجهز لرحلة طويلة، عرف أن لا زوادة تكفيه فيها، إلا تلك التي يختزنها المرء في وجدانه، وجه الأم البشوش، ضحكات الأب الرزينة وقطبة حاجبيه، رائحة الأخوة وآثار اللعب الطفولي المضيء معهم، خفقات القلب العنيفة لحب، يتأرجح وجوده في ذاكرته، بين الشك واليقين، ثم الشغف القديم الموشوم على رؤاه، وعندما قَدّحَ الزمان فتيل صبره باكراً، وضع بعضاً من كل شيء أحبه، في صرة للماضي والحاضر والمستقبل، وسافر إلى دمشق، المدينة التي أحبته، ومن أقمشة حياتها الناعمة، فصلت له قميصاً فريداً، ارتداه لبقية عمره، ممتناً لتلك المحبة الأنثوية الطابع، التي لم يتوقف سريان نسغها في شرايينه، مجاوراً حيناً وممتزجاً أحيانا أخرى، بالنسغ الوجودي لمدينة اللاذقية، التي منحته الحياة.
دراسته للفنون الجميلة، رسمت طرقاً واضحة المعالم، للحصان الصاهل في برية روحه، وألعاب الطين القديمة، صارت فناً احترفه مصطفى على واشتهر به “النحات” عالمياً، وهنا يحكي علي عن تلك المرحلة، التي استطاع فيها معلموه الكبار، “محمود حماد، إلياس الزيات، نصير شورى، نذير نبعة، فاتح المدرس” أن يعطوه مفاتيحاً أكثر حكمة لأبواب الفن الذي ينشده، ولتجيء تلك الأعطية، كما لو أنها لمسة من يد الزمان على صدره، هدأت روع الشاب المتفجر حينها؛ يتذكر بشيء من الامتنان الممزوج بالحنين، ما أخبره به “فاتح المدرس” بعد أن شاهد بعض أعماله: “أنت من الساحل، هذا واضح جدا في نتاجك بل وروحك”. تخرج عام 1978 من كلية الفنون الجميلة في دمشق، وفي عام 1988 أقام فيها أول معارضه وأهمها، والتي كان “البرونز” فيها هو البطل المطلق الحضور، خصوصاً وأن معرضاً من البرونز يُقام لأول مرة في سورية، وكان له تأثيره الكبير على مصطفى علي، بعد أن لقي المعرض نجاحاً كبيراً، محلياً وعربياً وعالمياً.
على سطح متحف العالم العربي في باريس، وفي مناطق عديدة من العالم، بين أمريكا واليابان، في أهم المتاحف العالمية والعربية، توجد اليوم أعمال الفنان مصطفى علي، الرجل الذي يمكنه أن يحيا أين يريد، لكنك إن فتشت عليه اليوم والبارحة وفي الغد أيضاً، فسوف تجده مرتدياً قميصه الدمشقي المشجر، وقبعته الأوغاريتية، متنقلاً بين الصالحية والشام القديمة، هناك حيث رُبط على قلبه، وفي شارع الأمين الذي كان شبه مهجور مطلع التسعينيات، أشاد من رمال شاطئ قريته ومن حصاه، تلك التي خبأها في جيوبه القديمة، بيته الفني وحمل اسم “غاليري مصطفى علي” الذي صار مركزاً فنياً عالمياً، وملتقى لأهم الورشات والمعارض الفنية العربية والعالمية، ولتتدفق الحياة في الشارع المهجور، صوب الغاليري ومنه، فنانون، كتّاب، شعراء، موسيقيون، أدباء، وغيرهم الكثير، قصدوا المكان، وأشادوا بالحياة المتوقدة الضاجة فيه، ثم كان للفتى الراكض في ذاكرته، أن قبض على هاجسه الفني مرة أخرى، فترك حياة الشهرة والعمل المزدهر وقرر أن عليه إطعام ذلك الفتى الجائع، فسافر إلى إيطاليا فناناً مشهوراً، وعاش فيها طالباً مغموراً للفن، وباحثاً لا يكل عن مواطنه الأكثر أصالة وروعة، وبعد أن ألقم فتاه الجائع ما يهدئ من جموحه، ولو لحين، عاد إلى دمشق التي منحته الحب، وبينها وبين اللاذقية التي منحته الحياة، عاش حياته مؤمناً بالسطوة المباركة للمكان الأول، حيث حنين الفتى دائماً إلى أول منزل.