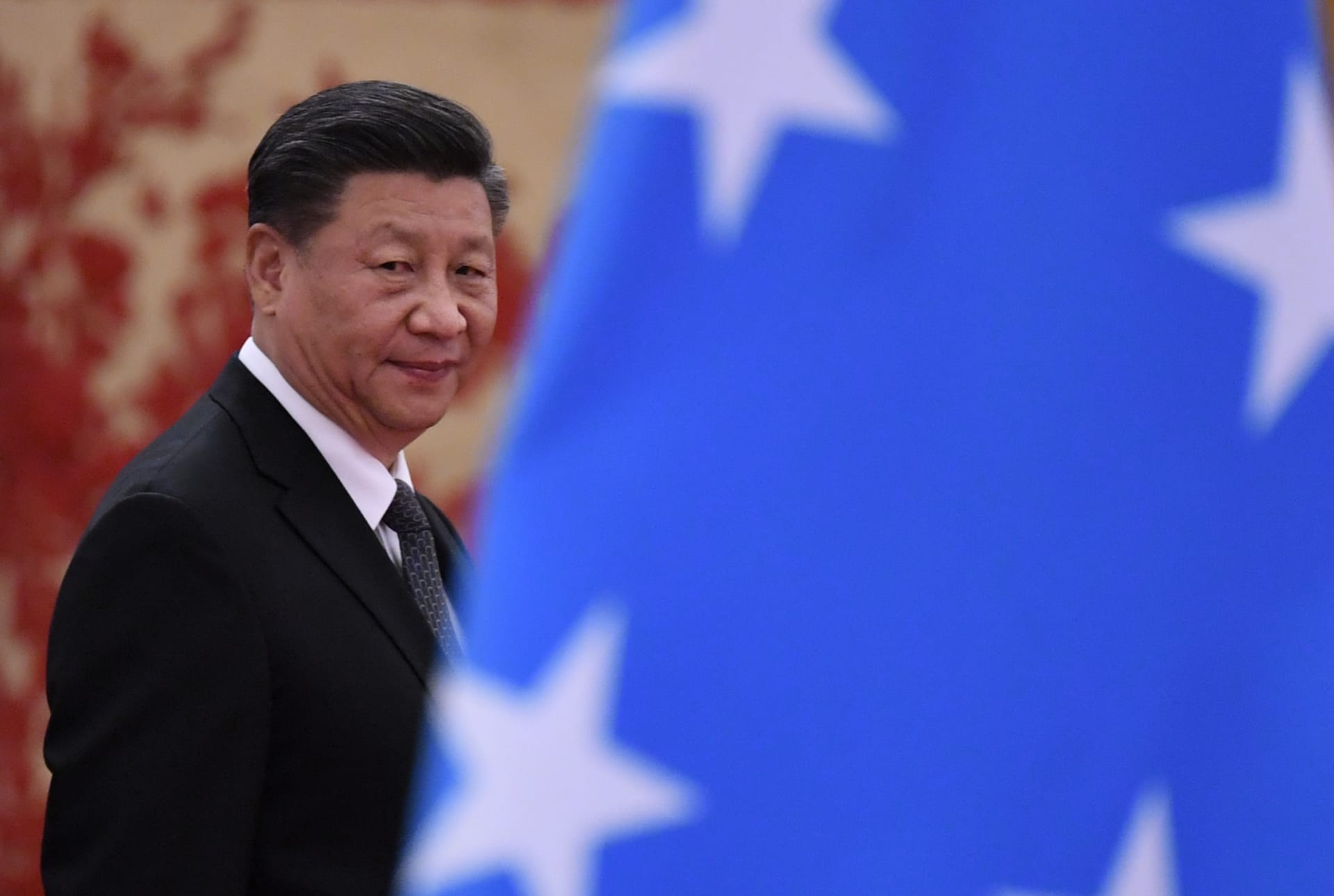الأسعار مستمرة بالارتفاع والقوة الشرائية تحت الضغط.. و”الوعود” لم تعد مقنعة
أول أمس، وكعادة “القرارات الليلية” تم تعديل أسعار المحروقات، حيث أصبح سعر ليتر البنزين “المدعم” 11000، وأوكتان 95 بـ 14110، والمازوت الحر بـ 12290، وهو الرفع الرابع خلال شهر، وقبلها بيوم أعلنت وزارة الكهرباء عن تسعيرة جديدة سيتم العمل بها اعتباراً من الشهر القادم، بالتأكيد إن رفع المحروقات والكهرباء سيؤدي أوتوماتيكياً لرفع أسعار الكثير من السلع، وبذلك تكون الزيادة الأخيرة على الرواتب قد تم “شفطها” قبل أن يأخذها الموظف ذو الدخل “المنتوف”، ومن يزور أسواق الهال أو أصغر محال بيع الخضروات والفواكه في الأسواق سيرى كيف أن الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور أشعلت السوق التي تُحلق بأسعار نارية لسلع منتجة محلياً وأيضاً المستوردة بما لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، بحجة ارتفاع أسعار المحروقات، وتذبذب سعر الصرف والسؤال هنا: من الأهم .. دعم المنتج أم دعم المواطن بأسعار مناسبة؟
ماذا بعد؟
لسان حال المواطن يقول: “شو فيه بعد رفع أسعار”، فهو في كل يوم يصحو على سعر جديد للمواد والسلع، علماً أن سعر الصرف الرسمي ثابت، والسؤال هنا: لماذا لا ينعكس ذلك على ثبات الأسعار؟!
هذه الدوامة التي يعيش فيها المواطن خلقت حالة من العجب والحيرة عنده على خلفية تأكيدات الحكومة على تحسين المستوى المعيشي خلال اجتماعاتها الأسبوعية في حين أن قراراتها تتنافى مع ذلك! فهل حقاً نفذت كل الحلول؟!
اليمين والشمال!
كما يستغرب خبراء الاقتصاد استمرار الحكومة على هذا المنوال وكأنها تثبت على نفسها مقولة “أعطونا باليمين وأخذوا بالشمال”. ويرى الكثير من الباحثين الاقتصاديين أن الحل الأمثل للخروج مما نحن فيه هو بتحسين الإنتاج الزراعي والصناعي وتخفيف الهدر، لأن ذلك من شأنه أن يخفف من التضخم، وبالنتيجة تحسين القدرة الشرائية وتنشيط الأسواق الراكدة، وكذلك توفير آلاف فرص العمل، وبغير ذلك سنبقى ندور في دوامة الحلول الترقيعية التي تشتري الوقت، بدلاً من أن تضع حلاً استراتيجياً لبتر جذور مشاكل اقتصادنا التائه بفعل القرارات غير المدروسة التي صدرت منذ بداية عام 2011 ولغاية اليوم.
غير مقتنعين!
والمواطن السوري، سواءً كان موظفاً أو عاملاً في القطاع الخاص أو من دون عمل، بات غير مقتنع أن الحكومة تدعمه بكل إمكاناتها “المتاحة”، ويوافقهم الرأي في ذلك كل الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية، فمجريات الواقع المعيشي والخدمي توحي بأن “حكي” الحكومة في واد وأفعالها في وادٍ آخر!.
أحد الزملاء الصحفيين المتخصصين في الشأن الاقتصادي سأل: لماذا لا تبادر الحكومة إلى تشكيل فريق من المستشارين المتخصصين لدعم قراراتها بغية مواكبة المتغيرات الكارثية التي أصابت اقتصادنا الوطني، وحولته من اقتصاد منتج إلى مستهلك بامتياز، ولماذا كل هذا الصمت المطبق وكأن الأمور لا تعنيها؟!.
بكل تأكيد لا يجوز ترك الأمور تمشي على هواها، فالناس باتت بأمس الحاجة لبصيص أمل! وفي ظل وجود إمكانية للحلول، يستغرب البعض أن تظل حبراً على ورق، مطالبين بإشراك كافة أطراف المعادلة بالحلول والأخذ بتوصياتها.
ويستغرب الخبراء التنمويون إصرار الفريق الاقتصادي على استنساخ سياسات تنموية لا تتوافق مع ظروف اقتصادنا، لذلك لا غرابة أن تبقى الكثير من القرارات الحكومية تجعل الجميع يشكك في صوابيتها، فاليوم لم يعد مفهوما أن يخسر الفلاح رغم موسمه الوفير، وبنفس الوقت يخسر المواطن لضعف قدرته الشرائية.
بالمختصر: الناس لا قدرة على تحمل “الوعود”، فالوجع المعيشي صعب، ومؤلم، وكل ذلك بسبب السياسات الاقتصادية القاصرة، إضافة إلى التهرب الضريبي نتيجة لهفوات قانونية وفساد الرقابة! وما زاد الطين بلة هو الفشل في استثمار الأموال المتاحة في مشاريع رابحة بدلاً من رميها في استثمارات ميتة كالعقارات والسيارات.
القاعدة والقائد
إن ما نحتاجه للخروج من عنق الزجاجة هو التخطيط الاستراتيجي، كي نحدد من خلاله ماذا نريد ونحتاج وفق الآليات المجدية والإمكانات المتاحة، وتحديد فترة زمنية لإنجاز ما نخطط له، فزمن التجريب والارتجال لا يجلب إلا المزيد من التعثر والخراب لاقتصادنا الذي لا يصلحه إلا إدارة مبدعة تفكك الأقفال المستعصية على اعتبار أن الإدارة هي مفتاح التنمية، فهل بات العثور عليها من المعجزات؟!
لا نعتقد ذلك فسورية فيها الكثير من الكفاءات المشهود لها، والتي تنتظر من يعطيها الثقة بقدراتها في إمكانية تقديم حلول ناجعة، عدا أن سورية فيها خبرات صناعية وزراعية وتجارية عريقة متوارثة قادرة على إنعاش اقتصادنا في شقيه الصناعي والزراعي والتجاري عندما نحسن التعامل مع تلك الخبرات، ويبقى الخوف أن تكون الحكومة قد نسيت القاعدة الاقتصادية التي تقول إن “الزراعة قاعدة عملية التنمية والصناعة قائدتها والإدارة الناجحة مفتاحها”.
غسان فطوم