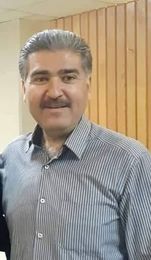المحراب.. فضاء من الإشارات والارتدادات والإشراقات العلوية
“البعث الأسبوعية” ــ غالية خوجة
اهتمت العمارة العربية الشرقية والإسلامية بالعديد من التفاصيل والكليات الفنية، ومنها مفردة المحراب، وما يدور في فضائها من المنبر وجدار القِبلة والحرم والمُصلّى؛ وتعتبر هذه المفردات من التراث الإنساني العالمي، كما تعتبر طقساً من الدلالات الروحانية المانحة للطمأنينة الداخلية والمجتمعية، لذلك، تميزت بأبعادها المعنوية والمادية والفنية تبعاً لكل عصر، لكنها اجتمعت على الجماليات المتناغمة مع الحالة وشفافيتها وأعماقها لتحقق أقصى طاقة ممكنة من السلام الجواني والمجتمعي والإنساني العام.
ويشير المحراب إلى حركة الذبذبات اللامرئية لأنها روحية، مثل الحالة الكهرومغناطيسية، وألوان الطاقة، وحيوية “الشاكرا”، كما يشير إلى الأفكار وأهمية الرأس بالنسبة للجسد؛ لذلك، نجده يتألف من عناصر عدة، أهمها التجويف، والعواميد، والقوس، والتاج، وكيفية تفاعلها مع الذبذبات المادية المكانية، وما ينتج عن فيزيائية الأجسام البشرية المتحركة وحرارتها؛ وهكذا، بإمكاننا القول إنه يتسع من القاعدة عند القدمين، ويضيق عند الرأس، وتتنوع تزييناته الفنية بين نقوش وكتابة ورسوم ومقرنصات وتشكيلات جمالية.
وللمحراب وظائفه الإشارية والعلمية والجغرافية كونه إشارة إلى اتجاه القِبلة، إضافة إلى وظيفة صوتية أخرى يؤديها من خلال تضخيم الصوت، ما يسمح لاهتزازات صوت الإمام أو الخطيب بالارتداد إلى أكبر مساحة ممكنة لتسمعها الغالبية.
وهناك بعض الدلائل على أن أول محراب كان مجوفاً، وبناه الرسول (ص) في أول مسجدين: المسجد النبوي الشريف، ومسجد قباء؛ ولربما كان محرابا مسجد بني أمية بدمشق وقبة الصخرة في فلسطين من أقدم المحاريب المزينة بنقوش فسيفسائية تتماوج بأشكال أخرى في مختلف جوامع العالم، ومنها مسجد الجمعة في أصفهان بإيران، ومسجد مولاي إدريس في فاس بالمغرب.
تختلف الثيمة الفنية بين المحاريب وموادها المادية، وتتشكّل، غالباً، من نقوش نباتية توريقية، وأشكال هندسية متداخلة، وتشكيلات حروفية وخطّيّة مختلفة، وجُمل عربية قد تكون قرآنية، وتأريخية، ورسوم ورقوش ونقوش، وفنيات زخرفية إبداعية؛ وقد تكون غزيرة البعد الجمالي، لتكون لوحة تشكيلية بحد ذاتها، وقد تكون بسيطة، لكنها تحافظ على عمق الدلالة الروحية مثل جامع سوسة التونسي، بينما تتسع الجماليات في محاريب أخرى لتكون مفردتها البنائية الجمالية حجرية مفرّغة مثل جامع قرطبة، أو لتكون خشبية مفرغة مثل محراب جامع المدرسة الحلوية بحلب المميز برقوش هندسية متماثلة مع محراب المسجد الأقصى بالقدس؛ ومن أهم ميزات محراب المدرسة الحلوية زخارفه النجمية، وكتابته الفنية بخط كوفي مزهر، بينما يحيط بالمحراب خط نسخي أيوبي يؤرخ لعهد الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن عبد العزيز محمد (1245 مـ)، ويعتقد أنه خط مؤرخ حلب الكبير كمال الدين بن العديم الذي كان يتولى المدرسة آنذاك.
ومن المحاريب الخشبية التي تشكّل لوحات فنية متفردة في حلب محراب الجامع الصغير بالقلعة، ومحراب الجامع الأموي الكبير بحلب، وكانت واجهته مرصعة بالعاج والأبنوس المتصلة بلا انفصال مع المنبر وجدار القبلة، على حد توثيق الرحالة الأندلسي ابن جبير الذي وصف جمالياته بدهشة: “ما أرى في بلدٍ من البلاد منبراً على شكله وغرابة صنعته، واتصلت الصنعة الخشبية منه إلى المحراب، فتجللت صفحاته كلها خشباً على تلك الصنعة الغريبة، وارتفع كالتاج العظيم على المحراب، وعلا حتى اتصل بسمك السقف، وهو مرصع كله بالعاج والأبنوس”.
واتسمت محاريب حلب بشكلها المجوف نصف الدائري، مثل محراب الرواق في جامع الصالحين، العائد للفترة السلجوقية (1112مـ)، بدلالة الخط الكوفي المنقوش على أعلى واجهته، كما يذكر اسم صانعه: فهد بن سلمان السرماني.
ولم تقتصر المحاريب على الجوامع فقط، لأنها موجودة في مبان أخرى، مثل المدارس والتكايا والزوايا، ومنها نذكر محاريب كل من مدرسة الأحمدية بمحلة الجلوم، والسلطانية أمام القلعة، والفردوس، والشاذبختية بسوق الزرب، والصاحبية بسويقة علي، وكان أغلبها محاريب رخامية ملونة متشابكة بفنيات هندسية حول قوس المحراب.
ويذكر المختصون أن المحاريب الرخامية أثناء الفترة المملوكية كان إيقاعها البساطة، وتعتمد على الرخام حتى مستوى الحنية، بينما الزخارف الهندسية فتزين القوس لاسيما أنصاف الدوائر المتشابكة المتناوبة للونين أو أكثر، وتظهر الواجهة حول القوس مزخرفة بألواح رخامية، والمثال على هذا النموذج محراب جامع الرومي.
ثم، بدأت تظهر المقرنصات في حنيات المحاريب، ومن أقدمها في جامع التكية الخسراوية، والتكية الوفائية، وجامع العادلية، وأهم ما يميز هذه المحاريب اعتمادها على التضليع، ليظهر المحراب المجوف بسبعة أضلاع، تزينه كثرة الزخارف، ومن هذا النموذج محراب جامع البهرمية بباب أنطاكية (1583مـ) المبني ضمن إيوان في الجهة الجنوبية من القبلية، ويتميز بحنية مقرنصة، وعمودين ملتحمين بالجدار، لكل منهما تاج مقرنص، وواجهته مزينة بألواح رخامية متشابكة.
معنى المحراب
والمحراب كلمة تعني صدر المكان، وأرفع حيز فيه، سيد المجالس وأكرمها، وربما عنت عرش الملك من القصر، وقيل للقبلة محراب كأشرف موضع في المكان، وهناك من أعادها إلى الحنية في المعابد والكنائس، وغيرهم أعادها إلى أن الرسول استخدم “الحربة” لتحديد اتجاه القبلة أثناء الصلاة في الفضاء.
وقد أكد ابن الأثير على معنى المحراب: “الموضع العالي المشرّف”، كما أنها دلالياً تعني نوعاً من المحاربة للظلمات الذاتية والنفسية والشهوات والغرائز والنفس الأمّارة بالسوء، وهذا ما يجعل الإنسان محارباً للشر الكامن في ذاته كلمةً وفعلاً، ويضفي عليه شجاعة الانتصار للعالم الروحاني النوراني العلوي على العالم المادي الظلماتي السفلي.
ضمن هذا الحيّز التأويلي، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة “المحراب” في عدة سور من القرآن الكريم منها سورة آل عمران، وسورة مريم عليها السلام التي وردت في الآية 11 منها كلمة المحراب: “فخرج على قومه من المحراب”، وفي دلالة هذه الكلمة ودلالات نسقها ما يختزل فيضان الأشعة الروحية المؤكدة على رفعة الأخلاق كمحراب أساسي: “وإنك لعلى خلُقٍ عظيم”.