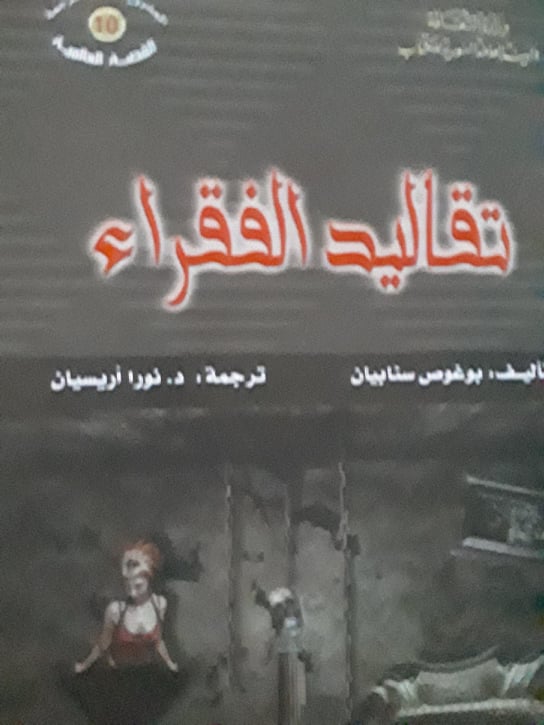شهداء سورية.. واجب الحق وحق الواجب .. كالصبح أو أرفع نورا
من هنا مروا، تركوا لنا ابتسامات ندية كالصبح في الصور، يحدقون إلينا والضحكة تعلو محياهم الورد، وكأنهم يعرفون أننا سنجلس طويلا أمام صورهم، نشعل شموع قلبنا، ونبدأ بسرد أحاديثهم التي تجود بها الذكرى والزمن، لقد كانوا هنا، لعبوا هنا، كبروا هنا، فرحوا وحزنوا واستشهدوا هنا لنبقى هنا، هذا ما قدموه لأوطانهم ولأهلوهم، أرواح بلون الشفق، طارت في سماء سورية، لترسم شروقاً سورياً لا يريم.
كتبنا كثيرا في سورية عن عيد الشهداء، تغنينا بهم وبعزهم في باحات المدارس، رفعنا أسماءهم والفخر يحط على أكتافنا كصقر أليف، إلا أنني لم يكن ليخطر في بالي “خصوصا في ظل الأمان الذي ارتحنا طويلا تحت ظلاله” أنني سأكتب عنهم وصورة كل من أخي وصديق عمري، اللذين استشهدا في العام المنصرم، ستكونان من بين شريط الذكريات الطويل، الذي يمرره السوريون بينهم من جيل إلى جيل، وكأنه إرث خالد، يحمله رجال سورية اليوم كما حمله آباؤهم وأجدادهم البارحة واليوم وغداً.
“رجال الحق” كانت من التسميات التي تمر في خاطري كالعديد من المسميات الأخرى التي نطلقها فخرا على شهدائنا، إلا أنها اليوم لم تفارقني، إنهم رجال الحق فعلاً، لأن الحق عندهم واجب، والواجب لا يصبح واجباً في ضمير من يحمله، حتى يصير حقاً، شهداء سورية اليوم كما البارحة، الشهادة هي واجبهم وحقهم معا، لا فرق بين المعنيين لديهم، إنهم حقاً أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر.
ما من بيت سوري شريف مر بما تمر به سوريته من الحزن والأسى، إلا وعلى حائطه تتربع محاطة بسورة الكرسي وعبق البخور صورة أحد أبنائه، وفي قلب أهله، يقعد الفقد والحزن محاطا بآيات الصبر والتجمل، وهناك بيوت صارت حيطانها، أسيجة من نور لا ينوس بريقه، بعد أن شيّع بابه كل أبنائه شهداء ميامين، ومنهم من لم يشيعهم إلا بالصور والذكريات.
قصص كثيرة سمعتها وحفظتها عن ظهر قلب وروح، عن روعة وبهاء بطولة، الكثير الكثير من شهداء سورية، خلال الحرب التي يخوضها أبناؤها الشرفاء، منذ ثلاث سنوات وحتى اللحظة، أو من أكثر من ما يقارب القرن من الزمن، طارت فيه حكايات شهدائنا، من شهداء ساحة المرجة “1916- شكري بك العسلي، رفيق رزق سلوم، الأمير عمر الجزائري”، مروا بشهداء الثورة السورية الكبرى “إبراهيم هنانو الشيخ صالح العلي، أحمد مريود، وغيرهم”، وشهداء تشرين المجيد وحتى اللحظة التي أخط فيها هذه الحروف، والدمع يسبقني إلى المعنى، قصص عابرة للأزمنة والتقاويم، محملة بعبير قانٍ رائحته مسك وعنبر، لا يشم عبقه إلا من غرس قلبه في تراب وطنه وأعار لله جمجمته، هؤلاء لم تكن تلك حكايات ما قبل النوم لهم في طفولتهم، أو درساً وموضوع تعبير يكتبونه في دفاترهم، أو شعار يرددونها ثم ينصرفوا إلى إشغالهم بعد أن ينتهوا منها، تلك كانت الحياة التي يريدون والتي اختاروا مشيئتها وأقدارها، وهم مؤمنون بأن لا طريق آخر ليعبدوا ما تبقى منه لخلاص بلادهم بدمائهم الذكية، اليانعة كتفاح الجولان، وزيتون ادلب وحوران، وليمون الساحل، وغار حلب، وقمح الحسكة ودير الزور. إلا أن قصة حضرت كل تفاصيلها وعشت كل لحظاتها، وبالتالي استطيع أن أوصفها دون أي حذلقة صحفية، ومبالغة عاطفية، لأنها تلج القلوب دون استئذان، كالنسمة تماما تحمل في هبوبها ألفة ذلك اليوم ووهج شمسه النيرة.
“أبو يوسف”.. أبو الشهداء..
عندما لاحت قامته المعتدلة وهو يدنو رويداً رويداً، من الجالسين في خيمة العزاء، وقف جميع الأشخاص الموجودين لتأدية واجب العزاء، وهم ينظرون صوبه، وبعضهم يذكر اسمه ويقول: أهلاً وسهلاً، جاء أبو يوسف، ما لفت انتباهي هو اتفاق أغلب الموجودين الضمني وغير المنسق له، على أن يقفوا معاً وبوقت واحد عندما يتعرفوا على هوية صاحب الطريق، وأن يلفظ الجميع بمهابة بالغة “أبو يوسف” اسم الرجل الذي بدأ بإلقاء السلام علينا، “السلام عليكم يا أوادم”.. رد الجميع السلام وانبروا يتقدمون باتجاهه لمصافحتهِ، صرت أحدث نفسي: من يكون هذا الرجل ذو القسمات العتيقة، الذي جاء مصطحبا معه، غيوم ألفة مفرحة غير متوقعة، في مصاب جلل؟ وما هو السمو الأخلاقي والإنساني، الذي يحيا به ولأجله ومن خلاله “أبو يوسف” بين نفسه وبين الناس، حتى يحظى بكل تلك المحبة المجبولة باحترام شديد ومؤثر فعلا من الجميع دون استثناء؟ أعفاني من حيرة التساؤل الفضولي الشديد، وكأنه أحس بما يختلج بداخلي أخي الكبير، فقال لي بفخر واحترام ومهابة: إنه “أبو يوسف”، والد الشهداء الأربعة، يوسف وثائر وعلي وفارس، أولاده الأربعة فقط، ثم أردف وهو ينظر صوبه ويتأمله مبتسماً: هل تصدق أن هذا الرجل المحتسب، القوي اليقين بالله، من يبتسم للجميع ويصافحهم بود وألفة بالغة، لم يفت عليه ثلاثين يوما من الأيام، التي مرت على وداعه ودفنه لأخر أولاده؟ انظر كم يدرك ما قيمة الشيء العظيم الذي صنعه أولاده باستشهادهم، وكم هو ممتن لله على محنة فراق أغلى الناس على قلبه، إنه رجل بحق. قلت لنفسي مستغرباً: ولكن ألا يحزن الرجال وتنفطر قلوبهم لفراق أحبابهم؟.
استوى “أبو يوسف” فوق كرسيه بعد أن صافح الجميع وأنا منهم، وأصابعه تقلب حبات سبحة زرقاء كانت بين يديه بتمهل، ثم طلب بلهجة محببة أن نقرأ الفاتحة على روح شهيدنا وأرواح شهداء سورية الشرفاء الطاهرين، دارت كلمات “الفاتحة” مع رائحة البخور بيننا، شعرت بـ “إياك نعبد” وكأنني أتنشقها بجسمي كله، دبت رعشة خفيفة في جسدي وعيني تلتقيان بعيني أبو يوسف للمرة الأولى، ابتسم لي وأومأ برأسه.
“أبو يوسف” من قرية بعيدة جغرافياً عن قريتنا بأميال، ولكنه أخذ عهداً على نفسه بعد استشهاد أوسط صبيته، قبل إخوته الثلاثة، أن لا يسمع بنبأ شهيد إلا وأن يقوم بواجب العزاء به، ومشاركة أهل الشهيد بمصابهم، بعد قسم عظيم بالله، أن لا يذهب إلى تأدية ذلك الواجب، إلا سيرا على الأقدام، مهما تباعدت أسفاره، فواجب الشهداء كبير والذهاب للسير في مواكب نورهم والتبرك بمرورهم الأخير فوق الأرض من أشرف الأعمال، كما أن واجب الشهداء لا يفيه حقه أي شيء بالدنيا مهما علا شأنه كما يوقن أبو يوسف.
قال أبو يوسف بعد أن حمد الله وأثنى عليه: عندما سمعت بنبأ استشهاد ولدي “علي” رحمه الله ورحم أمواتكم جميعا ورحمنا، كنت في مدينة اللاذقية، أشتري بذار للأرض، جاءني هاتف لا أعرف مِن مَن، فالرقم ظهر على جوالي دون أي اسم، لا أعرف كيف عرفتُ بالنبأ قبل أن أُجيب، وكأن هاتفاً روحانياً أخبرني، هاتف لا أملك حياله قراراً بالإجابة عليه أم لا، كما يفعل الكثيرون عندما تأتيهم اتصالات من أرقام لا يعرفونها وخصوصاً بعد بدء هذه الحرب القذرة على سورية الغالية، ربما لخشيتنا من الأخبار المحزنة. عندما قلتُ نعم، أتاني صوت كسير الخاطر، يخبرني بأن ابني قد “استُشهد” كما يستشهد الرجال الكرام النفوس في ميادين الكرامة، وعندما سمعني البائع الذي اشتري من عنده حاجياتي، أحمد الله وأشكره على هذه النعمة العظيمة التي مَنّ الله بها عليّ، سألني بعد أن فرغت من الهاتفين، “شو أبو يوسف ربحت اليانصيب”، قلت له ما ربحته أعظم ولله الحمد، شرف وفخر لا يهديه الله إلا لمن أحبه وأحب ذريته، لقد استشهد “عليّ” أوسط أبنائي، الحمد والفضل لك يا رب العالمين على هذه النعمة المباركة.
مرت بخاطري كغيمة شاردة قصيدة “ابن الرومي” في رثاء أوسط صبيته، وبدأت أرددها بصوت خفيض جداً:
توخى حمام الموت أوسط صبيتي فلله كيف اختار واسطة العقد
طواه الردى عني فأضحى مزاره بعيداً على قرب قريباً على بعد.
قطع حديث أبو يوسف، دخول معزين آخرين إلى مجلس العزاء، مع إصرار أحد القادمين بشدة، على تقبيل يده، وهو يقول له: “الأيدين يلي ربت هالأبطال، بتنباس وبتنحط عالراس من فوق، وهنيئاً للشخص اللي بيصافحك يا عمي أبو يوسف”، سحب أبو يوسف يده من بين يدي الرجل، وهو يستغفر الله ويقول له: حماك الله يا ولدي وحمى سورية وأبناءها الشرفاء المخلصين، ورحم شهداءها الطاهرين جميعاً.
روى لنا أبو يوسف كيف استقبل أنباء استشهاد أبنائه الأربعة تباعا، وكيف أن المدة الزمنية بين استشهاد الكبير من أولاده “يوسف” واستشهاد آخرهم “فارس” لم تتجاوز الشهرين، كنت أنظر إليه وأنا أرى تجاعيد وجهه السمح، يزداد ألمها كلما ذكر اسم أحد أبنائه، رأيت حزن الفراق، ورضى غريب به، شاهدت كيف يستحيل الإنسان نبياً بخضوعه لمشيئة ربه وقبوله لأمره مهما كان قاسيا، صوت هذا الرجل، لا يجيء من تلاعب الهواء بحباله الصوتية مثلنا، بل ينسكب مع شلالات ألفة رحيمة، آتياً من محبة إلهية خالصة، أدركت كم أنا ضعيف بالمقارنة مع رجل كمثل “أبو يوسف”، يحتشد الإيمان في قلبه جميعاً، إيمان بالحياة كما الموت، بالفرح كما الحزن، بالزهد في مقاصد الحياة ومظاهرها، ورحت أفكر بجملة قالها في معرض حديثه مناجياً بها ربه بعد أن سمع بنبأ استشهاد أوسط صبيته وأولهم: “ربي أخذتَ أمانتك الغالية من عندي وأبارك لك بها من قلبي يا الله، بارك لي يا ألهي بمن تبقى مِن مَن أئتمنتني عليهم من البنين”.
عندما صافحت أبو يوسف وأنا أشيّعه مع الآخرين إلى خارج مجلس العزاء، قال لي فمه: نار فرقة الأحبة يا بني لا تنطفئ، بل تزيد جذوتها بتقادم الأيام” وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ”، لكن عيناه الصافيتين كينبوع، أجابتا على سؤالي: نعم يا ولدي الرجال يحزنون وتنكسر قلوبهم لفراق أحبتهم فراق الموت أكثر من غيرهم من الناس.
أبو يوسف رجل سوري فقد جميع أبنائه، يناجي ربه ويدعو إليه أن ربي إني من الصادقين بإذنك، وأتمنى الموت شهيداً إن تكرمت عليّ، واجمعني بأولادي، إلهي أنعم على أمتك وابن أمتك بالشهادة، كما مننت بها على أولادي ونولني شرفها يا أكرم الأكرمين، إنك على كل شيء قدير.
تمام علي بركات